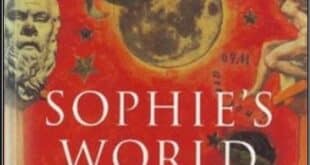مقدمة الترجمة
ينبغي أن يُفهَم تاريخ الفلسفة كسلسلة من الادعاءات الفكريّة والأخلاقيّة الخَطِرة حول القضايا الأساسيّة. مثلا، إنّ اعتناق أيّ اعتقاد إنّما ينطوي على التضحية بجميع البدائل من أجل هذا الاعتقاد، فهل يعني ذلك أنّ اعتناق أي اعتقاد يجب أن يكون مسألة يقين؟ وهل يمكننا أن نكون متيقنين من أيّ شيء؟ أضِف إلى ذلك، في حال تبنّينا اعتقادا دون فحصه واختباره، فهل ذلك يثير الأسئلة التي تتعلّق بالنزاهة الفكريّة والشخصيّة؟ وهل السعي إلى حقيقة نفسها، حتما لا مفرّ، مسألة أخلاقيّة؟
نص التقرير
لقد أرسى مفكرو اليونان القديمة الأسس لما أصبحَ فلسفة غربيّة، وكان من أوائلهم كزينوفانيس (570-480 قبل الميلاد) الذي زعمَ أنّ المعرفة البشريّة لها طابع الاعتقاد، والذي بسببه ليس بمقدورنا أن “نعرف” الواقع. وهناك، على المستوى الأخلاقيّ الشخصيّ، سؤال كيف السبيل الأمثل لأن يحيا المرء حياته، وهو الأمر الذي تصوّره اليونانيّون باعتباره “الحياة الطيّبة”.
والحال أنّ الإجابات الفلسفيّة تراوحت منذ ذلك الحين من تعزيز البحث عن السعادة الشخصية إلى الاضطلاع بحسّ لا-أنانيّ لواجب خدمة الآخرين. لقد نصحنا مؤسّس الرواقيّة، ألا وهو زينون الرواقيّ (334-262 قبل الميلاد)، بأنّ الإنسان هو جزء من الطبيعة، وليس فوقها، ولذا فإننا يجب أن نعيش على نحو أخلاقيّ مستقيم، بينما نقبل بالقيود المحيطة بنا بكلّ شجاعة. أمّا الاعتدال فناصره أرسطو (384-322 قبل الميلاد) أيضا، والذي يشمل على تقييم لمعنى الفضائل المختلفة والممارسة المتناسقة لها ممارسة متناسبة، والتي أطلق عليها اسم “التوسّط”. وهناك قاعدة أخلاقية واسعة تُعرَف باسم “القاعدة الذهبية” -“افعل للآخرين ما تحبّ أن يفعلوه لك”- وُجدت في العديد من الأديان، بل وعُزيت نسخة منها أيضا إلى كونفوشيوس. وفي الوقت نفسه، وضع بوذا “الطريق النبيل الثماني” كسبيل للخروج من المعاناة الناجمة عن الرغبات غير قابلة للتحقيق من أجل الملذات والسلطة والمتاع.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=489&v=VJRvTaJw1y8
من النّهضة إلى التنوير
مع ظهور الإنسانويّة في عصر النهضة في القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر تركزت اهتمامات الفلاسفة الأخلاقيين بشكل متزايد على الاستجابة للمآزق الدنيويّة، وبدأت الفلسفةُ في إظهار الاتّكال المتزايد على العقل بدلا من الاعتقاد الدينيّ. وأتت التغييرات في المواقف تجاه المعرفة (تعني “النهضة” “إحياء المعرفة”) جزئيّا من توافر النصوص اليونانيّة والعربيّة المترجمة، وبالتالي من حافز الثقافات المختلفة. ووقعت أزمات العقل والمعتقد الدينيّ لكوبرنيكوس وغاليليو وكبلر، رغم أنّ ليوناردو دافينشي شعرَ بحريّة في الكشف عن عمل الجسم البشريّ من خلال تشريح الجثث.
وبدأت البنى السياسية أيضا تخضع للتدقيق والفحص، وفي عام 1651 نشرَ توماس هوبز كتابه “اللفياثان” لتعزيز وجهة نظر الحكومة على أنها تعاقديّة، وبالتالي الدعوة إلى “التوسّط”، بحيث يتوازن النّظام مع الحريّة. وكان من الممكن تفادي احتمال اندلاع الحرب الأهليّة والعودة إلى حالة من انعدام القانون إلى حدّ أنّ الولاء للسيادة هو ثمن يستحق دفع ثمن الأمن العامّ والفرص اللاحقة للتقدم الشخصيّ. وكان جون لوك (1632-1704) حذِرا من السلطة السياديّة، وحاجج بأنّ العقد الاجتماعي لهوبز، الذي يقيّد الحريّة الشخصيّة إلى حد كبير في مقابل حماية الدولة المقصودة من الخروج على القانون، ينبغي أن يتضمن حقوقا مدنيّة بعينها، وأحدها حريّة إزالة ملك استبداديّ أو حكومة سيّئة.
وقد تم تكريس تناظرات بين الحريّات الشخصيّة والحقوق الطبيعيّة، كما تم تطوير مفهوم الحضارة والذي تمركزَ حولَ المفهوم الجديد لـ “الحريّة”. وغدا مَثالُ الحريّة هو الشغل الشّاغل الأوروبيّ، لا سيّما مع كتابات فولتير (1694-1778) وروسّو (1712-1778) التي ناصرت الثورات في فرنسا وأميركا. وقد ظهر هذا الانشغال بالحريّة في وقت لاحق في كتابات جون ستيوارت مِلْ (1806-1873)، الذي عزّزَ حقَّنا في أن نتصرّف كما نرغبُ طالما أننا لا نمنع الآخرين من القيام بمثل ما نقوم به. وقد ألهمت أفكار من فرنسا المدرسة “النفعية” البريطانيّة، التي أسسها جيريمي بنثام (1748-1832) الذي اخترع فكرة “حساب السعادة”، حيث “أعظم سعادة لأكبر عدد… هو مقياس الصواب والخطأ”. بالنسبة إلى بنثام فإنّ الأخلاقيّة تحدّدها عواقب أعمالِنا، وهو متناقض ههنا مع أخلاقيّة مِلْ المتمركزة حول فكرة الحريّة الشخصيّة، حتى وإنْ كان مِلْ نفسه نفعيّا.
https://www.youtube.com/watch?v=nvTzv9iCwno&t=112s
وقد ارتبطت العلوم والرياضيات ارتباطا وثيقا بالعقلانيّة -أي فكرة أنّ العقل الخالص يمكن أن يكتشف الحقيقة- مع التحقيق التجريبيّ، وهو الأمر الذي سمحَ بالتقدّم التكنولوجي المذهل في القرنين السابع عشر والثامن عشر وتحديد المشهد للثورة الصناعيّة. يُطلَق على هذه القرون اسم “عصور العقل” أو “عصور التنوير”.
وادّعى رينيه ديكارت (1596-1650) دليلا على وجوده فقط عن طريق الاعتراف بقدرته على التفكير (“أنا أفكّر إذًا أنا موجود”). وفي عام 1949 حاجج الفيلسوف البريطاني جيلبرت رايل أنّ ديكارت قد ارتكب “خطأ تصنيفيّا”، وهو خطأ التفكير في العقل كمكان حيث الأفكار والمشاعر تحدث مماثلة لأجسادنا كونها موقع حواسّنا، على الرغم من أن العقل هو “شبح لا-ماديّ في الإنسان”. والحال أنّ الفلسفة تقنّعت بهذه “الأشباح” المجرّدة، وتعاملت ببرءاة، ولكن بصورة زائفة، معها ككيانات تنتمي إلى عالم الأشياء.
وعلى النّقيض من النّهج العقلانويّ المجرّد لديكارت تعاملت النزعة التجريبيّة البريطانيّة في القرنين السابع عشر والقرن الثامن عشر مع العقل كأفضل تطبيق من خلال اختبار العالم القابل للاكتشاف من خلال حواسنا والسهل الانقياد للتجريب. وقد وصف هوبز ولوك العالم بمصطلحات ماديّة وميكانيكيّة. وقد بدأ ذلك لأول مرة على يد فرانسيس بيكون (1561-1626) كدراسة منهجيّة بهذه المصطلحات الماديّة والميكانيكيّة.
وقد حوّل المفكرون الفرنسيّون، بمن فيهم أوغست كونت (1798-1857)، التجريبيّة إلى نزعة وضعيّة، أي الاعتقاد بأنّ المعرفة تقتصر على ما يمكن التحقق منه “وضعيّا”. وقد نشأ هذا الشرط كاحتجاج ضد التفسيرات العقلانيّة التي تبدو ملوثة بإفراطها في الميتافيزيقا. طبّق كونت الوضعيّة في محاولة لاكتشاف قوانين السلوك الاجتماعيّ. (لم يستطع ماركس أن يتفق مع علم الاجتماع الكونتيّ، على الرغم من أنّه قد وافقَ تماما على أن التحقيق السوسيولوجيّ يجب أن يكون علميا، وأن الميتافيزيقا يجب أن تُنسَى).
صعود الأفكار الألمانيّة
في القرن الثامن عشر حوّلت الفلسفة الألمانيّة الميتافيزيقيّ بقوّة. فقد اقترحت “المثاليّة الترنسندنتاليّة” لإيمانويل كانط (1724-1804) عالما تفهمه الحواسّ (الظاهرة) ولكن، في الوقت نفسه، تعزّزه حقيقة مستقلّة عن الحواس التي لا نستطيع أن نعرفها (الشيء في ذاته). واعتبرَ كانط ما سمّاه بـ”مقولات” فهمنا -أي مفاهيم المادّة، والزمكان، وأمور أخرى- أنّها القدرات السليقيّة للفكر، بحيث عندما نواجه أشياء جديدة في العالم فإنّنا نكون مجّهزين طبيعيّا لفهمها من حيث هذه المقولات. واستعادَ كانط أيضا فكرة الباعث (motive)، لا العواقب، باعتبارها عنصرا جوهريّا في الحكم على السّلوك البشريّ أخلاقيّا، وخَلُصَ إلى أنّ المرء يجب ألّا يتعامل مع شخص آخر فقط كمجرّد وسيلة لغرض ما. وآمنَ كانط أيضا بأنّ القوانين الأخلاقيّة الكونيّة موجودة كـ “ضرورات قاطعة” تتطلّب الامتثال التام.
وجاء بعد كانط في ألمانيا نفرٌ من الفلاسفة “المثاليين” (أي الذين يقولون إنّ “الواقع أمر عقليّ”)، والذين ضمّوا الأفكار إلى عالم تصوّفيّ في الغالب. مثلا، يمكننا أن نعقد مقارنة بين فيتشه وشيلينغ. وقد وافقَ ديفيد هيوم في إسكتلندا كانط بأنّ القوانين العلميّة لا يمكن استخلاصها من تأملات العالم، لكنّ فيتشه قال إنّه لدينا بنية عقليّة سليقيّة تسمح لنا بالاستدلال على الواقع، وأنّ “الأنا” -أي الذات العارِفة- تتسبّب في بِدوّ الواقع باعتبارها “لا-أنا”، ولكن تحت مظلّة طابع الطبيعة الأخلاقيّة الجوهريّة للإنسان. وقد اعترض شيلينغ على أنّ الذات العارفة ليس بمقدورها أن توجد من دون أن يكون هناك شيء ما موجود للمعرفة بالفعل، وأنّ الطبيعةَ سيرورة إبداعيّة لدى الإنسان في الأعالي. (أُعِيدت هذه الأفكار، وحُوِّلَت، في حجج القرن التاسع عشر لأجل تطور أشكال الحياة عن طريق الانتقاء الطبيعيّ). والحال أنّ هذه الملاحظات كانت ملاحظات بارعة تسلّط الضوء على مشكلة الملاحظة بموضوعيّة لعالَم ينطوي، هو نفسه، على الملاحِظ.
“كارل ماركس أعجب بفيورباخ، متفقا معه بأنّ الإله هو محضُ إسقاط للأماني والمخاوف البشريّة، ومعيدا تشكيل مثاليّة هيغل لفهم التاريخ البشريّ باعتباره “ماديّة ديالكتيكيّة””
وقد عقّد آرثر شوبنهاور المسائل مزيدا عن طريق فصل كانط بين الظاهرة والشيء في ذاته، لكنّهما الآن جوانب من الشيء نفسه: فالإرادة هي الشيءُ في ذاتِه، وتمثيلها هو الظاهرة. إذ بمقدورنا أن نعرف مباشرة إرادتنا، ولكن ليس إرادة الشيء أيضا (أو إرادة شخص ما)، والتي ليس بمقدورنا سوى تمثيلها فحسب. ولأنّ الزمان والمكان لا يوجدان في عالم الشيء لذاته فإنّ الإرادةَ هي مصدر لا متمايز وكونيّ للطاقة، بحيث تسيطر على العالم المتمايز للتمثيل.
أمّا بالنسبة إلى هيغل فالعالمُ نفسه لا-ماديّ -روح- وفي سيرورة تطوّر تشكّل تقدّم التاريخ، وهي السيرورة التي تُظهر البنية الفطريّة للرّوح. ولذا، فإنّنا مع هيغل، خلافا للمقولات الثابتة لدى كانط بشأن الفهم، أقول إنّنا مع هيغل لدينا وعي متطوّر باستمرار. إذ إنّ ديناميّة التقدّم هي تفاعل “ديالكتيكيّ” للمتناقضات: فالفرضيّة تتعارض مع اللافرضيّة لتنتج توليفة تصبحُ هي الفرضيّة الجديدة. لذا، مثلا، يتصارعُ الاستبدادُ مع الحريّة لتشكيل شكل من العدالة المنظّمة، وهذا يمثّل نتيجة تقدميّة وتصاعديّة. إنّ كلَّ عصر، بالنسبة إلى هيغل، له روحه الخاصّة التي تُبْدِي وتَشْرط الأفكار وفهم ذلك العصر. وإذا كانت أفكارنا غير متطابقة مع الرّوح فإننّا قد نشعرُ بالاغتراب، أي الإحساس بالعزلة والقلق واللامعنى.
قلبَ فيورباخ أفكار هيغل رأسا على عقب، مستبدلا الماديّة بمثاليّة هيغل. فبالنسبة إليه ليس ثمّة “روح”، ويجب فهم اللاهوت كأنثربولوجيا. وقد أُعجب كارل ماركس بفيورباخ، متفقا معه بأنّ الإلهَ هو محضُ إسقاط للأماني والمخاوف البشريّة، ومعيدا تشكيل مثاليّة هيغل لفهم التاريخ البشريّ باعتباره “ماديّة ديالكتيكيّة”، والذي أوّلهُ على أنّه منطوٍ على سيرورة حتمّية نحو مجتمع لا-طبقيّ، تلك السيروة التي يمكن التسريع بها من خلال الثورة. فالمصير البشريّ وحده الإنسان مَن يحدّده: فالدين “أفيون الشعوب”. وفي كتابه “رأس المال” تُقدَّم الرأسماليّة كنظام اقتصاديّ متزعزع حيث صاحب الشغل والشّغيل هما تروس منزوعة عنهما البشريّة في ماكينة صناعيّة، وبالتالي مغتربان عن العمل الإبداعيّ.
هموم وجوديّة
من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا بدأ الفلاسفةُ يبتعدون عن النّظر في ميتافيزيقيّة الواقع الموضوعيّ نحو النّظر في المشكلات الكينونيّة للهويّة والمسؤوليّة الشخصيّة، في الهنا والآن، مع التركيز بشكل كبير على الإنسان ووضعه، الفاني والمولود بمحض الصدفة. فإذا كان العالم لا معنى له ولا-شخصي، فما التوجيهات للحياة؟ وماذا تصبح مفاهيم مثل الخير والشرّ؟
بدأت إعادة التوجيه الأخلاقيّ هذه فلسفيّا مع سورين كيركيغارد وفريدريك نيتشه. حيث اعترض كيركيجارد على الفرد الذي يُعامَل كجزء من حركة التاريخ الكونيّ، وادّعى لنفسه وللآخرين حريّة الاختيار. واعتبر كيركيجارد أنّه من مسؤولية كلّ شخص التي لا مفرّ منها أن يعيش حياته القصيرة إلى أقصى حدّ، ويبحث عن المعنى، ويقبل أيّ التزامات تنشأ عن ذلك. إذ تجعلنا هذه المسؤولية نشعر بالقلق.
استلهمَ كريكجارد و نيتشه ضربين مماثلين من التفكير: الظاهراتيّة والوجوديّة. وتختلف الظاهراتيّة والوجوديّة في اهتماماتهما ونمط مُساءلتهما، ولكنهما على حد سواء مضادتان للميتافيزيقا بمعنى الرغبة في التركيز على العالم كما يُنظَرُ إليه مباشرة، وباستبعاد أنواع معينة من السؤال الميتافيزيقيّ. إدموند هوسرل، مؤسس الظاهراتيّة، نظرَ في مشكلات الفرديّة بطريقة نسقيّة، وتجاهل عمدا أي مسألة لم تنشأ عن وعينا المباشر بالعالم، ما أسماه بـ “عالم الحياة”: حيث اهتمّ فقط بتجربتنا الشخصيّة الأولى. وقد أثارَ ذلك الأمر نظرا عميقا لمعنى وحالة الإفصاح المبتدئ بـ”الأنا”: ماذا يعني أنّني “أتصرّف”، على سبيل المثال؟
اخترق تلميذ هوسرل مارتن هيدغر الصفّ بإضافته إلى ظواهر وعينا ظاهرة وجودنا -أي وجودنا في العالم (الدرازين)- التي حددها هيدغر بمرور الزمان. بالنسبة إلى هيدغر كوننا بشرا هو أمر يحدّده المسار الزمانيّ لحيواتنا، وأيضا الحاجة إلى جعلها ذات معنى، على نحو ما، من خلال العيش بـ “أصالة”، أي من خلال إدراك فنائيّتنا. هذا الوعي الذاتيّ القَلِقُ والحاجة إلى خلق معنى هو ما ميّز الوجودية باعتبارها تعبيرا عن “معنى اللحظة”. ومع ذلك، ليس هناك سوى خط رفيع ظاهراتيّة، مثلا، موريس ميرليو-بونتي ووجودية جان بول سارتر، وسيمون دي بوفوار، وألبرت كامو. بالنسبة إلى كافّة هؤلاء المفكرين فإنّ وجودنا الحادث المفاجئ ليقدّم سؤال ما يجب أن نصبح عليه. ادّعى سارتر أنه في البحث عن الهويّة الشخصيّة لا يمكننا الهرب من المسؤوليّة الشخصيّة، ولا المجتمع: فـ “الآخرون هم الجحيمُ”. وواجه كامو إشكاليّة المعنى الشخصيّ بشكل صارم من حيث “السخافة”.
متأثرا بداروين، اقترح هنري بيرغسون أنّ الحياة البشريّة محاصرة في سيرورة تطوريّة، في حركة خلق أماميّة. وحاججَ بيرغسون بأننا لسنا مجهزين بشكل خاص للفكر أو الفهم المجرد: فخصائصنا البشريّة تتشكل من الانتقاء الطبيعيّ فقط لبقائنا، وليس لنا أن نفهم الكون ومكاننا فيه. إن وعينا بمرور الوقت، بحسب بيرغسون، كان نتيجة “قوة الحياة” التي تشتبكُ معنا في تجربتنا للواقع.
اللغة والحقيقة والمنطق
جذب صعود العلم في القرن التاسع عشر الكثير من الاهتمام الفلسفي. ومن المهم أن نلاحظ الفرق بين ما هو مجرد وجهة نظر منطقية والإطار المفاهيمي العلمي القائم على التجربة للفهم. ومن ثم، فإن علم النفس والاقتصاد وعلم الاجتماع هي علوم لينة لأنها تفتقر إلى الإجراءات التجريبية الواضحة كالتي في الكيمياء والفيزياء.
وأخيرا (وكما قد كان)، فإن الاهتمام تركز على اللغة كمجال للدراسة العلمية. تم استكشاف السيميائية (علم العلامات) من قبل فيرديناند دي سوسير (1857-1913) من حيث المفهوم الثنائي لـ “الرمز” و”الدلالة”. أصبح تحليل المعنى النصي هدف “البنيويين” مثل رونالد بارت (1915-1980) ولوي ألتوسير (1918-1990)، والمحلل النفسي جاك لاكان (1901-1981) والأنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس (1908-2009). بارت وألتوسير طورا السيميائية للنقطة التي قرر فيها ميشيل فوكو (1926-1984) وجاك دريدا (1930-2004) أن من الممكن تفسير الخطاب الإنساني من خلال “تفكيك” اللغة، كما سماها دريدا. (تفكير مشابه في الثيولوجيا تركز على “التنقيح”).
وقد أدى النهج التفكيكي في نهاية المطاف إلى “ما بعد البنيوية”، والذي وفقا له كان التعبير عن الحقيقة يُعدّ قائما على المنطق الدائري والإحالة على الذات. ففي أميركا أنشأ شارل بيرس (1839-1914) مدرسة فكرية تعتمد على وجهة نظر “البراغماتية” بأن مفهومنا للشيء يعتمد على المهم فيه لنا.
وبالنسبة للبراغماتية فإنه لا يتعين على المعرفة أن تمثل العالم ما عدا ما هو مطلوب لتفسير كاف لمهمة أو وضع. (كطريقة للتعامل مع الحقائق، فإن وجهة النظر هذه تقف في مكان ما بين العلم والوضعية.) فصّل ويليام جيمس البراغماتية، كما حاول تقديم دراسة علمية للوعي، حيث ابتكر عبارة “تيار الوعي” [يرجى الاطلاع أيضا على “حياة موجزة” لهذه المسألة]. اتبع جون ديوي (1859-1952) النهج البراغماتي من خلال توسيع مفهوم فائدة “التعلم من خلال النشاط”. وهنا المدخلات الحسية إما أن تهيئ العقل وإما أن تدمج أفكارا اكتُسبَت في مكان آخر. ومن الناحية الأخلاقية فإن براغماتية ديوي تتماشى مع أي عقد اجتماعي، تركز بدلا من ذلك على حق الفرد المواطن وحاجته إلى تحقيق الذات، وتدعو إلى توفير التعليم من أجل إنتاج “مجتمع أخلاقي”.
وفي الآونة الأخيرة فإن ريتشارد رورتي (1931-2007) من خلال تبنيه لنهج “البراغماتية” قد رفض وجهة النظر القائلة إن معرفتنا هي “مرآة الطبيعة”، أي إن حواسنا ومنطقنا معا يوفران انعكاسا حقيقيا للعالم. وبالنسبة لرورتي فإن وعينا يأتي من خلال مفهمتنا للمعلومات الحسية في صيغ لغوية، وبالتالي ربط الحقيقة بالاستخدام اللغوي الحالي. وهناك درجة من النسبية لا مفر منها في الحقيقة. طور توماس كون (1922-1996) مفهوم “البرادايم”، تبقى فيه الحقيقة في صيغ مؤقتة.
وعلى النقيض من البراغماتيين فقد أصر غوتلوب فريجة (1848-1925) في ألمانيا على أن المنطق قائم بذاته مستقل عن عمليات التفكير التي كشفها علم النفس. وفي إنجلترا أثبت برتراند راسل (1872-1970) وألفريد نورث وايتدهيد (1861-1947) أن هوية الرياضيات والمنطق مما يشجع الاعتقاد بإمكانية المعرفة الموضوعية للعالم من خلال العلم. (وقد طور وايتهيد نظرية حول سير الكون، عائدا إلى هيجل وفيورباخ وبرجسون). وقد بدأ التطبيق لقوة المنطق في الإجراءات المعروفة بالفلسفة التحليلية. وقد ابتكرت الرمزية بهدف تقديم مقترحات لغوية بعبارات منطقية ودمجها للحصول على تعبيرات صادقة تماما أو كاذبة تماما. لكن سرعان ما بدا واضحا أن المقترحات المعبر عنها لغويا ليست بالعموم غير مبهمة بحيث يمكن ربطها تحت أي نوع بسيط من التحليل المنطقي. وعلى سبيل المثال، فإن تعبير “الرجل الذي على القمر عارٍ” يثبت أن من الصعب تحليله منطقيا، ناهيك عن التحقق منه.
وتظهر الفلسفة التحليلية بشكل بارز في تفكير لودفيغ فيتغنشتاين (1889-1951)، الذي يقول في كتابه Tractatus Logico-Philosophicus (1922) إن العالم هو “مجموع الحقائق، وليس الأشياء”. وقد تحول القلق حول البنية المنطقية في النهاية إلى لغوية، ودراسة بنية التعابير من حيث القواعد والسيميائية. طوّر نعوم تشومسكي (1928-) وجهة النظر بأن كل اللغات الإنسانية تستغل القواعد الفطرية، بالرغم من أنه لم يُثبت إمكانية بناء هذه الفكرة علميا.
أظهرت التجارب المبكرة مع الماركسية والفاشية (بما في ذلك النازية) أن الأيديولوجيا بحد ذاتها لا يمكنها أن توفر الاستقرار السياسي ما لم يكن الاتصال السياسي (وبالتالي القيم المشتركة) محدودة. وأيضا فقد رأينا أن نظاما سياسيا ينبغي ألا يقع في أيدي قلة، أو أننا سنعود إلى حكم الأقلية أو الحكومة الاستبدادية. ومع ذلك، فقد حاول مفكرون متمركزون في فرانكفورت، بما في ذلك هربرت ماركوزه (1898-1979) وجورج لوكاش (1885-1971) ويورغان هابرماس (1929-) إنقاذ الفكر الماركسي من تجاوزات الطغاة كستالين بالقدر ذاته الذي حاولوا فيه إنقاذه من قوة الرأسمالية. فقد طوروا نظرية نقدية من أجل محاولة تقديم ديناميكية أيديولوجية جديدة، بما أن كلا من الشيوعية والرأسمالية تبدوان أحافير فكرية.
كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال
مواقع التواصل
وصولا إلى التفكير الحديث، يعارض سلافوي جيجك (1949-) القبول السلبي لفشل كل من الماركسية والرأسمالية، ويحث على إعادة النظر في أحدهما واستغلال الانهيار الوشيك للآخر. وفي أميركا، فقد وازن جون رولس (1921-2002) بين العدالة والإنصاف من خلال التجربة الفكرية التي من خلالها يختار الناس قواعد المجتمع من دون معرفة ما سيكون موقعهم فيها. وبالرغم من ذلك فقد واجه روبرت نوزيك (1938-2002) هذه الصيغة للعدالة، وهو الذي لم يوازن بين العدالة والإنصاف، بل بينها وبين الحرية القائمة على حقوق الملكية.
خاتمة
ادّعى الفيلسوف العقلاني المثير للقلق برنارد ويليام في حاشية كتابه الإتيقيا وحدود الفلسفة (1990) أن الفلسفة الأخلاقية تستند إلى الحقيقة ومعنى الحياة الفردية، وأن العلوم الطبيعية قادرة على الحقيقة الموضوعية. تدور الفسلفة الغربية حول هاتين الفكرتين -بالرغم من أنه بالنسبة لي فإن “الحقيقة الموضوعية” للعلوم يمكن فهمها على أفضل وجه بوصفها تمثيلية أو مجازية، بصفتها تقدم صورا أو نماذج نفهم الحقيقة من خلالها. إن تجربتنا في الكون تبدو وكأنها متماسكة معا وكأنها مترابطة تماما، ولكن بعض جوانب تجربتنا تقف بعيدا عن البقية وكأنها حقائق مختلفة، ولا سيما الإتيقيا والاستاطيقا.
الفلسفة الإتيقية والحساسيات الاستاطيقية والعلم جميعها متعددة المستويات، وبالرغم من ذلك فقد تبقى الروابط المتبادلة بين المناطق والمستويات غير واضحة لبعض الوقت. أعتقد أن المشكلة الأساسية للفلسفة في أوائل القرن الحادي والعشرين هي الأصولية، حيث تُعدّ بعض الاعتقادات بعيدة عن أي موضع شك.
لا يحتاج المرء أن ينحاز إلى جانب حتى يستنكر الكراهية المتبادلة التي تبديها الأصولية الدينية وغيرها من الفصائل، والتي غالبا ما تكون على أساس الحرب، حيث توجد خلافات كامنة، وإنكار صارخ لقيمة ونزاهة الحياة الفردية. يمكن أن تبدأ نظمنا التعليمية بوضع هذا الحق، ليس فقط من خلال التماس التسامح المتبادل، ولكن من خلال تعليم الوضوح الفكري: طرق وإجراءات التفكير المنطقي. ينبغي على كل واحد منا أن يتعلم التعرف على المغالطة، وقبول المفارقة، مع الإبقاء على إنسانيتنا.
__________________________________________________________
الرابط مترجم عن: فيلوسوفي ناو