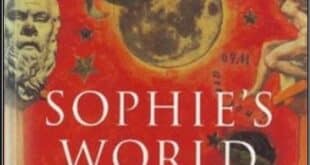تعرف على نفسك إن كنت ما زلت تفكر بطريقة قروسطية أو حديثة
كيف تعرف أنك تعيش بعقلية القرون الوُسطى؟!
عماد أبو الفتوح، 2018/09/28
مؤخراً، كنتُ قد كوّنتُ نظرية شخصية لا بأس بها أرتاح لها تماماً، مفادها باختصار أننا في العالم العربي حالياً نعيش ظروفاً شديدة التشابه بأوروبا في القرون الوسيطة…
أوروبا الزرقاء الأنيقة الآن، المليئة بالجبال الخضراء، والوجوه الشقراء النضـرة، والتقنية والحداثة والنظافة والإدارة، والتنظيم والخدمات والإبداع، لم تكن كذلك قبل 500 سنة كما تعرفون جميعاً، عندما كانت التسلية الوحيدة المُتاحة للناس وقتها هي قتل بعضهم بعضاً لإعلاء كلمة الرب.
ولكوني مُحباً لقراءة التاريخ، وجدت أنه من المُمتع فعلاً أن أوضّح لماذا نعيش في ظروف مُشابهة لـ (أوروبا القرونوسطيّة) كما يُطلِق عليها الأكاديميّون والمتحذلقون، ولكن بطريقة مُختلفة قليلاً.. طريقة المُقارنة الفكرية بشكل فردي، وليس المقارنات الاجتماعية العامة بين (الشعوب الأوروبية) و (الشعوب العربية) بشكل عام.
اقرأ أيضاً: افضل افلام الاكشن لعام 2017 .. أهم أفلام الأكشن والحركة في 2017 حتى الآن
(دليل) سريع مُبسَّط يوضّح لك إن كنتَ أنت نفسك تعيش بعقلية القرون الوسطى الأوروبية في القرن الحادي والعشرين، أم أنك تعيش بمفردات وأدوات العصر..
أنت تعيش بعقلية القرون الوسطى الأوروبية، عندما:
تعتبر أن كلمة (الحرية) مُرادفة للتحلل الأخلاقي!
عندما تسمع تعبير (الحرية)، لاحظ أفكارك، إذا قفز في ذهنك فوراً بلا تفكير – بمجرد سماع كلمة (الحرية) – مفهوم التحرر الجنسي، والعلاقات الجنسية المُشينة، والشذوذ والسحاق وكل هذه الكلمات المُريعة.. فيجب أن تعرف فوراً أنك على رأس قائمة المُفكرين بعقلية القرون الوسطى.
في القرون الوسطى، كان إذا نوديَ بالحرية بين المثقفين والنخب بغرض التطوّر السياسي والمُجتمعي – عادة -، فأوّل ماكان يتبادر لذهن العامّة المُحافظين وقتها أن المطلوب هو الحرية الجنسية، هكذا فقط وبشكل مُباشر، دون إسقاط مفهوم الحرية على حق التعبير والتفكير، والاعتراض والتأييد، والانتماء السياسي والفكري.
نفس الوضع هنا، تترك كل هذه المعاني الشاملة لمفهوم (الحرّية)، وتفكر وأنت ممتقع الوجه بأن الحُرية المقصودة هي حرية الجنس، وأن تمشي النساء في الشوارع عرايا، ويتقافز الناس بعضهم بعضاً في الطُرقات.
الحريّة لها مليون بُعد آخر ومعنى آخر، وفهم آخر ومقاصد أخرى أكثر أهمية بكثير جداً من اهتماماتك بأنشطة نصفك السُفلي. أنت تخشى جداً كلمة (الحرّية) فقط لأنك تعرف تماماً أنّ بداخلك وحشاً مُريعاً سيتحرر بمجرّد رفع الغطاء!
وعندما لا تستريح لكلمة (مواطنة)!
تخيفك جداً هذه الكلمة، تقلقك، وتجعلك تفكّر بعصبية وحذر، وتهاجم وتعترض على من ينادي بها.. كيف يجرؤ أحد أن يُنادي بإعلاء مبدأ المواطنة، الذي يعني المُساواة بين البشر في البلد الواحد؟
في البلد العربي الواحد متعدد الطوائف، كل حزب بما لديهم فرحون. السُنّي يريد أن يعيش في وطن هو السيّد فيه، وبقية الطوائف والأديان درجة ثانية، لا تُهنهم ولا تظلمهم، ولكنهم – شاؤوا أم أبوا – درجة ثانية في هذا الوطن..
المسلم الشيعي يرى أنه السيّد في هذا الوطن، وكل الطوائف درجة ثانية، لا تُهنهم ولا تظلمهم، ولكنهم – شاؤوا أم أبوا – درجة ثانية في هذا الوطن..
المسيحي العربي يرى أنه السيد في هذا الوطن، وصاحب الوطن الحقيقي، وكل الطوائف والأديان الأخرى مُستعمِرون، ويجب أن يكونوا – شاؤوا أم أبوا – درجة ثانية في هذا الوطن..
وهكذا مع بقية الطوائف الدينية والعرقية والاجتماعية .. الأكراد والأمازيغ والمسلمين والمسيحيين، وطبقات النبلاء والنخب، وحتى الليبراليين والعلمانيين وغيرهم .. كل منهم يعتبر أنه (السيّد)، وأن شريعته هي التي يجب تطبيقها بشكل حاسم – وفقاً لفهمه – والتي تُعطيه أفضلية ولو معنويّة على الطوائف والمعتقدات الأخرى..
فقط عندما ينادي مُنادٍ بإعلاء قيمة (المواطنة) وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات والمُعاملات بشكل كامل، تجد أن كل الفـِرق تتحد في السعي إلى سحقه وتكفيره وتخوينه، وتضليله وتفسيقه واتهامه بأنه متآمر ضد الدين والوطن.
هذا الملمح بالذات من أهم ملامح عقلية القرون الوسطى، التي سادت أوروبا لسنوات طويلة جداً.
وعندما ترعبك الأفكار المُخالفة لما تربّيت عليه!
في القرون الوسطى الأوروبية، كان أكثر شيء مُخيف للعامّي أن يقع أمامه فكرٌ مُخالف لفكر الكنيسة أو يروّج لكنيسة أخرى، ناهيك عن الترويج للأفكار العلمية والإنسانية بعيداً عن مفهوم الكنيسة.
مُجرد تناول هذه الأفكار ومناقشتها، لا يُعرّضه فقط للمساءلة من السلطات، بل ويعرّضه لأزمات نفسية وعقدة ذنب بالغة: كيف جرأتُ أن أقرأ كتاباً أو أتعرضَ لفكرٍ مخالف لفكر المُجتمع والحياة الذي نعيشه؟
“تُحكى قصة رائعة من التراث الإسلامي، أن وردت أنباء لأحد العلماء في العراق، في أحد عصور المُسلمين المُزدهرة، عن وجود كتاب ينتقد الإسلام بشدة في إحدى مكتبات بغداد. فما كان من العالِم إلا أن قطع رحلة طويلة مُرهقة إلى بغداد، حتى وصل إليها وسأل عن المكتبة التي وُضعَ فيها الكتاب للاطّلاع عليه.
لما وصل المكتبة، سأل أمينها – أمين المكتبة المسؤول عن أرشفة الكتب – عن هذا الكتاب المثير للجدل، فجاءه الرجل بكتاب فارغ، كل صفحاته بيضاء تماماً، لا يوجد بها أثر الكلمات! فسأله العالِم: أين الكلمات؟ الكتاب فارغ المحتوى!
فأخبره أمين المكتبة أنه قام بمسح كل الكلمات في كل الصفحات، لأنه وجد مُعظم الكتاب كفراً، فمسحه حتى لا يقرأه أحد، ولا يقع في يد أحد!
فقال له العالِم: ألا قبّحك الله! عسى أن يكون ماكُتِب في هذا الكتاب صحيحاً، فنرتاح من اتّباع دين خاطئ! أو يكون خاطئاً فنرد عليه بالحجّة الصائبة، ونأخذ منه ما يثبت صحة ديننا، ويؤكّد منهجنا، وتطمئن قلوبنا بالإيمان!”
إذا كنتَ تعيش بعقلية هذا العالِم المُسلم المُنفتح، السابق لعصره، فأنت تعيش بالضبط في زمانك الصحيح (القرن الحادي والعشرين)، أما إذا كنتَ تعيش بعقلية أمين المكتبة المُرتعش الخائف من مجرد قراءة أفكار مُخالفة للأفكار التي نشأ وتربّى عليها فأهلاً بك في القرون الوسطى!
عندما يكون تركيزك كله منصبّاً على قضايا عجيبة!
هل الموسيقى حرام أم حلال؟ هل يجوز الشرب من الإناء مُباشرة؟ هل يجوز مُصافحة الأجنبي؟ هل ارتداء البنطلون حرام؟ هل يجوز الأكل بالملعقة؟
من المهم أن يلتزم الإنسان حرفياً بمنهاج دينه، فلكل تصوّراته للدين وتطبيقاته، ولكني – صدقاً – لا أفهم أن يكون كل تفكيرك مُنصباً على هذه القضايا، في الوقت الذي لا تفعل فيه أي شيء تقريباً في حياتك!
في الوقت الذي يخرج فيه البشر للتوسع فى الفضاء، وإسقاط المسبارات على المذنبات، وتشييد مصانع عملاقة، والعمل على تسخير تكنولوجيا الخلايا الجذعية لإعادة استخراج الأطراف المبتورة.. أنت كل اهتمامك في الحياة هو جواز الأكل بالملعقة؟
كأنك انتهيت لتوّك من إتمام دورك التاريخي في التأثير على البشرية، وأنجزت كل واجباتك الدينية الأساسية، وساهمت في القضاء على الجوع والفقر في الدول العربية كلها، وبقي عليك أن تطمئن (هل الأكل بالملعقة حلال أم حرام؟) قبل أن تغادر الدنيا.
وقتئذ أنت نسخة حقيقية من طبيعة تفكير البشر في أوروبا في فترة القرون الوسطى، الذين انتشرت لديهم هذه المنهجية في التفكير – وربما أكثر تشدداً – في التعاطي مع أمور شديدة الهامشية في الحياة، مثل طريقة المأكل والملبس والموسيقى إلخ.. بينما الحضارة العربية الإسلامية في نفس الوقت كانت تحرز تقدماً مُذهلاً في الفيزياء والكيمياء والميكانيكا، وحركة النقل والترجمة من الكتب، والتوسع الثقافي والمعرفي.
عندما تُصرّ على استحضار التراث إلى الواقع!
# عندما يكون مفهومك عن (الدولة) هو نفس المفهوم الذي تعاطت معه كتب التراث من 700 سنة، وترفض بشدة مفهوم تكوين الدول والمؤسسات الحالي وتعتبره (بدعة).
# عندما يكون مفهومك عن النزاعات السياسية التي دارت من 1000 عام هو – تقريباً – نفس مفهومك الحالي، بل وتصرّ – باستماتة – على استحضاره كل يوم.
# عندما تكون فكرتك عن الحياة والتطوّر والتعامل مع الآخر، وحتى المفردات اللغوية المُستخدمة بنفس منظور الناس الذين عاشوا من 1000 عام، فإذا جاء من يجدد – وفقاً لمستجدات العصر – اتهمته بالنفاق والرِدّة والبُطلان، والخروج عن الصف.
# عندما تتعامل مع (التراث) باعتباره (عقيدة) يجب الدفاع عنها بإيجابياتها وسلبياتها، وتهمل مفهوم العقيدة نفسه وجوهرها.
# عندما تتعامل مع فكرة (الحضارة) باعتبارها مُرادفاً للتوسع العسكري، أو (الفتح)، وتردد دائماً أننا يوماً ما سنغزو العالم، ونعيد مجد حضارتنا، فأنت تستحضر تراثاً قرونوسطياً بامتياز، ونموذجاً إنسانياً غابراً مرّ وانقضى وتطوّر ورحل تماماً إلى غير رجعة، حتى في أدبيات الدول الاستعمارية!
غزو العالم – الآن – يكون بإطلاق الأقمار الصناعية، وبناء محطات الفضاء، والسباق التقني المحموم، وتحقيق مُنجزات هائلة في العلوم والآداب، تجعل العالم كله يأتي إليك طواعية، بدلاً من أن تذهب إليه بنفسك.
إذا كنت مُصرّاً دائماً على استحضار التراث، وإسقاطه على الواقع المُعاصر بكل أدواته الجديدة، فأنت – حتماً – تمتلك عقلية قرونوسطيّة ممتازة.
رعمسيس الثاني.. هل هو الفرعون الطاغية المذكور في الكتب السماوية؟! – تقرير
عندما تفسّر كل شيء حولك بـ “نظرية المؤامرة”!
كما ذكرتُ سابقاً، نظرية المؤامرة حقيقية بالمفهوم التنافسي الإنساني بين البشر والمجتمعات. الكل يتآمر على الكل، ويسعى لتحقيق مصالحه وأفكاره، ويفرض نفوذه، ويقوّي من وجوده.
أما أن تمتلئ مكتبتك بكتب من نوعية (أحجار على رقعة الشطرنج) و (بروتوكولات حكماء صهيون)، وتقضي ساعات طويلة لقراءة هذه الكتب المليئة بالفكر المَرضي والتي ستحوّلك بعد الانتهاء من قراءتها إلى إنسان شيزوفريني مريض مُتشكك في كل شيء حولك.. كل حدث حولك وراءه مؤامرة.. كل شخص يبتسم لك يريد أن يتآمر عليك.. كل من هو مُختلف عنك فكرياً أو عقائدياً هو حتماً شخص مُتآمر يُريد أن يُهلكك.
# تسمع كلمة تنوير، يقفز لذهنك فوراً (الماسونية). طيب، هل تعرف ما المقصود بمصطلح التنوير أصلاً؟ لا، ولكنها شيء شرير.
# تسمع كلمة فلسفة، يقفـز لذهنك فوراً (الهرطقة والإلحاد). هل قرأت كتاباً واحداً في الفلسفة؟ لا، ولكنها شيء شرير حتماً.
# تسمع كلمة (التوافق)، يقفز لذهنك فوراً (التنازل عن المبادئ). هل سمعت شرحاً من قبل عن مفهوم (التوافق) سياسياً واجتماعياً وفكرياً؟ لا، ولكنها – حتماً – شيء شرير.
الخوف.. الحياة بنظرية المؤامرة.. الرعب من المُصطلحات، خواص مهمة جداً يجب أن تجدها في كل من يعيش بعقل يعود إلى فكر القرون الوسطى.
إذا قرأت تاريخ أوروبا جيداً، ستجد أن 70% من الحروب الدامية التي اشتعلت بين المذاهب والأعراق والجنسيات الأوروبية المختلفة، والتي راح ضحيتها الملايين – لدرجة اهتزاز النسب السكانية للمجتمعات وقرب انقراضها تماماً! -، سببها اعتناق الحُكام والناس دائماً فكرة: الآخرون يتآمرون علينا. لذلك يجب أن نستبق الخطوة ونُشعل حرباً ندمّرهم تماماً بها، قبل أن يدمرونا هم!
عندما تعيش بفكرة أنك محور الكون كله!
هل تعرف لماذا تم شنّ 11 حملة صليبية على العالم الإسلامي في القرون الوسطى؟!
من ضمن الأسباب العديدة هو أن الفكر المسيحي المتشدد في أوروبا وقتها يفترض أن المسيحي هو كلمة الرب، وأن الله لم يخلق سواه، وأن كل ماغيرهم – في العالم – ليسوا إلا أعداءاً يجب قتالهم، واستلاب أراضيهم، ولا بأس من عمل مجازر جماعية من أجل هذا الهدف.
هل تعيش بنفس المبدأ؟ أمصمم أنك أنت الوحيد الذي تملك الحقيقة المُطلقة، وأنك ظل الله على الأرض، ولديك الحق المُطلق في تطبيق فهمك للنص المُقدس دون غيرك؟ وأن جماعتك / مذهبك / فكرك، هو الصحيح، وكل ماعدا ذلك على كوكب الأرض بملياراته البشرية باطل يجب دحره تماماً؟
في رأيي الشخصـي، هذه الحالة الفكرية منتشرة بشكل مُذهل في بلادنا العربية، إما بشكل واضح صريح مُباشر، أو بشكل غير مباشر، من وراء وراء!
تؤمن أن الله جعلك محور الكون كله.. الله اصطفاك وأهلك وعشيرتك عن بقية مليارات البشر.. أنت دائماً على حق، والأغيار دائماً على باطل.. طيب لماذا خلقهم الله أصلاًَ؟ لماذا خلق الله 950 مليون هندوسي، و350 مليون بوذي، و 3 مذاهب مسيحية ضخمة العدد، ومذاهب إسلامية متعددة، وأعراقاً وألواناً وجنسيّات بلا حصر؟
ثم تأتي أنت لتنكر هذا القانون الإلهي المُطلق في التنوّع والاختلاف، والحقيقة الإلهية (جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، لتصمم أنت بالنهاية – بمفهومك الضيّق عن الحياة كلها – بأنك أنت فقط الذي على صواب، وأنك أنت فقط الذي تحتكر الحديث باسم الله، وكل ماهو خارج إطار فهمك هو حتماً باطل.
هل يوجد عصر يمكنك أن تعيش فيه بهذه الأفكار، سوى العصور الوسطى المظلمة؟!
عندما تقرأ هذه الكتب.. فقط لا غير!
عندما تمتلئ مكتبتك بأمثلة كتب (رياض الصالحين) و (منهاج المُسلم) – فقط لا غير – إن كنتَ مُسلماً سُنّي المذهب، أو كتب (بحار الأنوار الجامعة) و (أصول الكافي) – فقط لا غير – إن كنتَ مُسلماً شيعي المذهب، أو كتب مثل (الأجبية المقدسة) – فقط لا غير – إن كنتَ مسيحي الديانة، وغيرها من كتب الدين المُختلفة، هي كل ماتقرؤه في حياتك فقط لا غير، مع أهمّية هذه الكتب جميعاً وضـرورتها لفهم مبادئ دينك الذي تعتقنه.
ولكن، في نفس الوقت، تنظر إلى كتب من نوعية (الكون) لكارل ساغان، أو رواية (الحرب والسلام) لتولستوي، أو كتب تشارلز ديكينز، ومؤلفات إسحاق عظيموف، وكتب الإدارة الذكية، وآخر مُنجزات الحضارة البشرية.. تنظر لهذه الكتب باعتبارها مضيعة للوقت، وأن الحمقى فقط من يقرؤون هذه الكتب! أو تلمّح بأنها (كتب الزنادقة)!
وعندما ترى صديقك يشتري هذه الكتب ، فتخبره ساخراً – أو غاضباً – أنه من الأَولى والأجدر أن يقرأ في كتب الدين (فقط)، بدلاً من هذه الكتب غير المفيدة، وتلمّح له أنها (مضيعة للوقت) وأنها (علم غير نافع)، وأنها تروّج للفاحشة والإلحاد والزنا والربا والأخلاق المتدنيّة، دون أن يكون لك أي علم مُسبق بها!
هذه الحالة بالضبط مُطابقة تماماً بشكل هائل لنفس العقلية السائدة بين الناس في القرون الوسطى، عندما كانت القراءة معناها (الكتاب المقدس) و أقوال الآباء فقط، وكل ماغير ذلك هو محض هراء، أو محرّم لأنه ربما يثير الشك، أو علامة للرغبة في التحرر من العقيدة، أو لأنه (علم لا ينفع)!
إذا كانت كل قراءاتك في الدين (فقط)، وتعترض على قراءة ما سوى الدين، وتتشكك فيه، بل وتحرّمه ضمنياً داخلك.. فتأكد أنك كنت ستعيش حياة هانئة ممتازة في القرون الوسطى، وأن حظك العاثر هو الذي جعلك تعيش في القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد!
أخيراً، عندما تقرأ كل ماسبق، وتعتبره مُخالفاً لآرائك في الحياة، وبدلاً من أن تلجأ للنقاش وإيضاح مواطن الاتفاق والاختلاف، فتميل للحل الأسهل والمحبب، وهو أن تتهم الكاتب في تعليقك بأنه كافر، مُلحد، ماسوني، عقلاني، تطوّري، علماني، صهيوصليبي، أنجلو ساكسوني إلخ.. لأنه فقط حاول المقاربة بين واقع عربي نعيشه جميعاً، وماضٍ عاشته أمة قريبة منا جغرافياًً.. تأكد – وقتئذ – أيضاً أن كل ماجاء في الدليل المذكور أعلاه كان صحيحاً!