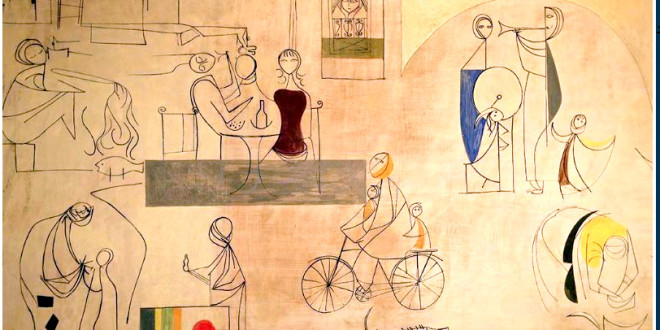حارث حسن *
كما معظم الحواضر التاريخية العربية، تفقد بغداد صفتها الكوزموبوليتية بعد أن دخلت طور التخندق وراء عصبويات تمزج الميتافيزيقيا بالعشيرة، وتحارب بعضها في صراع مظلوميات متبادلة يجدد نفسه مع كل سيارة مفخخة تنفجر في شوارعها، او عائلة تهجر من أحيائها. سياسات الاقصاء التي هيمنت على السياسة وعلاقتها بالمجتمع طوال عمر الدولة الحديثة، تستولد باستمرار ثقافات اقصائية، وتعيد انتاج العنف كفاعل رئيسي في تشكيل العلاقات السياسية – الاجتماعية، وصناعة الـ”نحن” والـ”هم”.
خضع الفضاء البغدادي في المرحلة البعثية/ الصدامية لشكل من سلطة مهجنة لاجتماع الحزب والعشيرة، وأُعيد تشكيل مجمله ليعكس صورة القبيلة “الرسالية” المحاربة وراء “الفارس البدوي” الذي كان يستنكر علناً ربط المدينة بصفة البغددة (وهو تعبير مصري يشير الى حالة الرفاه والدّعة). سعى نظام صدام الى تعزيز قيم الذكورة و”الخشونة” في التشكل الخطابي والمكاني أنذاك، في النصب والتماثيل التي انتشرت لتقدم مزيجاً من التعبئة الحربية والاحتفاء بشخص الزعيم، ونوع من رقابة “الأخ الأكبر” الذي كان شاخصاً في كل مكان ليُذكر الناس انه موجود حيثما ذهبوا.
التفكيك: سنة وشيعة لا غير
يخضع هذا الفضاء اليوم لعملية تفكيك وتشظّ ليعكس مرحلة متقدمة اخرى باتجاه تعميق الفجوة بين بغداد في “المخيال” الثقافي الذي ساد طويلا وعرّفها كمدينة كوزموبولوتية متنوعة وليبرالية دينياً، وبين واقعها الذي ما زال يسير باتجاه مزيد من التقويض لما تبقى من تجسدات لذلك المخيال، خصوصاً عبر صراع “الطوائف” التي يراد لها أن تصبح هويات نهائية، حيث لا شيء في بغداد غير سنة وشيعة، وهؤلاء ليسوا أي شيء آخر غير سنة وشيعة. هذا الصراع لا يكتفي بإنتاج سرديات اقصائية جديدة، بل يصنع جغرافيا خوف وتربص بين مركز تسكنه اليوم غالبية شيعية، وأطراف تسكنها غالبية سنية.
تفقد بغداد مزيداً من مناطق “الحياد”، تلك الطوائف التي لا تُعرّف نفسها بوصفها شيعية أو سنية، واولئك الشيعة والسنة الذين لا يعرّفون أنفسهم كجزء من طوائف. تتواصل عملية الفرز والفصل وتضيق جغرافيا الاختلاط وتعبيراتها. واذ يحتدم الصراع وتقرع “داعش” طبول “الزحف على بغداد” ـ تلك الفكرة التي أطلقها قبل أكثر من عام أحد شيوخ التعبئة من على منبره ـ تتعمق حالة التخندق، وينكشف الفضاء المحايد عن حالة ضعفٍ وتلاشٍ. عندما تختفي الفضاءات المحايدة، تصبح بغداد جبهة تفصل خندقيها حدوداً مكانية واهنة، ولكنها ايضا حدود ثقافية تزداد رصانة مع تصاعد العنف وتعمق السرديات التي تبرره.
ليست بغداد استثناء عن مسارالتخندق وشيوع ثقافة عدم التسامح والكراهية الدينية والطائفية، فهو أمر تشهده معظم المدن العربية الكبرى بسبب عوامل الضغط الديمغرافي وفشل وعد “التحديث” بنسخته الكولونيالية، وتحول موازين القوى لصالح العواصم والامارات البترولية. لكن بغداد تختلف بطريقتين: فهي أولاً العاصمة الأكثر تعرضا للعنف في المنطقة بل والعالم، ولهذا السبب تصر التصنيفات التجارية التي ترعاها شركات استشارية متخصصة بالتصميم الحضري على وضعها في ذيل قائمة التصنيف الحضري او السياحي للمدن في العالم، وثانياً لأنها – خلافاً لدمشق والقاهرة وبيروت – عاصمة لدولة بترولية جداً (أكثر من 93 في المئة من الميزانية الحكومية العراقية مصدره عوائد النفط، وهي نسبة تجعل العراق البلد الأشد اعتماداً على البترول في المنطقة).
العنف والبترول معاً
لعب العنف والبترول دوراً في تشكيل وتفكيك واعادة تشكيل المدينة حتى أصبحت ما هي عليه اليوم: قرية كبيرة بملامح خافتة وفضاء تسكنه ايقونات الحداثة المشوهة والسرديات الطائفية وجدران الكونكريت والسيطرات العسكرية. فالعنف كان دائماً مجسداً سياسياً لعلاقات الإقصاء، مارسته السلطة تجاه مجتمعها، او مارسه جزء من المجتمع تجاه جزء آخر، او تم نقله الى الجبهات في صورة صراع مع الآخر هدفه الاساسي هو اخفاء الصراع مع الذات، او اخفاء عجز السلطة عن ان تحقق ذاتاً عراقية. فوجود “ذات عراقية” بهوية وملامح واضحة يظل يهدد أي سلطة تبني شرعيتها على اقصاء عناصر في الجسد الاجتماعي والثقافي العراقي، وعلى ايديولوجيات محورها السعي لمغادرة هذا الجسد (البعثوية، الإسلام السياسي، العقائد الطائفية). منذ فرهود الأربعينيات الذي استهدف السكان اليهود وأسس لبداية طرد الوجودات “الشاذة” من جسد المدينة وصعود ايديولوجيات الهوية، انفتح الباب لما وصفه بطل “حارس التبغ”، للروائي العراقي علي بدر، بديماغوجية “الجماهير المنفلتة”، صارت النزعات الثورية والتغييرية تشحن بعصبويات يمينية كتلك التي أفرج عنها “الربيع العربي” مؤخراً.
استكمل البترول ذلك المسار حينما عزز من سلطوية السلطة وقدرتها على “ابتداع” مبرر لشرعيتها واستمراريتها بمعزل عن المجتمع، بل واخضاع ذلك المجتمع واستتباعه، كما حصل في الحقبة التوتاليتارية (1975-1991) حينما هيمن خطاب سياسي وثقافي وهوياتي واحد، رافقته عمليات “تطهر” من وجودات “شاذة” اخرى كالسكان من “التبعية الايرانية” و”الكرد الفيليين”.
يواصل العنف والبترول دورهما السلبي في تشويه بغداد وتغييب أي افق لسلام دائم او تنمية حقيقية. تُظهر خرائط بغداد الأخيرة ديموغرافيا غير متسامحة، وحالة فرز ديني وطائفي غير مسبوقة، ونهاية لطوائف دينية غير مسلمة. تغلغَل المنطق السياسي للنظام الذي اقيم بعد الاحتلال على معادلة “سنة وشيعة وكرد” الى الجسد المجتمعي، كي ينتج حقائق اجتماعية جديدة عمّقها العنف المنفلت للجماعات المتطرفة والمقترن بصراع اقليمي على النفوذ يقوم بدوره بتوظيف التضامنات الطائفية. لا يتعلق الأمر فقط بالانقسام بين الطائفتين، بل وبالمحتوى السردي الذي يسعى لتعريفهما بالضد من بعضهما، فتسنن اليوم المشحون بنزعة سلفية يمثل قطيعة عن سنية بغداد “الحنفية”، وبالتأكيد قطيعة مع تراثها الصوفي الغني الذي ما زالت تذكر به قبور معروف الكرخي وعبد القادر الكيلاني وابو بكر الشبلي والحلاج. يتم تشكيل التسنن سياسياً وخطابياً ليكون بالضد من الآخر “الشيعي”، بينما يواصل التشيع السياسي اعادة انتاج “مظلومية” الماضي بخطابها التبسيطي والمختزل، ليسقطه على الحاضر رغم ان الجماعات المنتمية له تهيمن في الحقيقة على مقاليد السلطة والموارد.
السردية كضد ـ واقع
ينتج صدام المظلوميات مزيداً من التشظي لبغداد ولفضائها ولهويتها، وبينما تواصل السردية الطائفية السنية التعبير عن “الحنين” لبغداد “السنية” والتعبئة من أجل استعادتها، غير عابئة بحقائق ديموغرافية لم تعد تزكي فكرة “سنية بغداد”، تعجز النخب الطائفية الشيعية عن موضعة بغداد في منظور وطني منفتح، بل تحركها رغبة الاستحواذ قصيرة الأمد، بينما تعتبر السردية التاريخية الشيعية المدينة عاصمة لخلفاء بني العباس الذين اضطهدوا أئمة الطائفة وقتلوهم. لا يمكن لأي من السرديتين أن تنسجم مع واقع المدينة الديموغرافي اليوم، ولا مع تاريخها، ويصبح سعي كل منهما للسيادة مواصلة لصراع بلا نهاية لامتلاك الجغرافيا عبر امتلاك التاريخ.
ويكمل النفط بماله السهل عملية التشويه بعد ان بات وسيلة لتكريس الفساد السياسي، والتنافس بين العصب السياسية حول المواقع وما تدره من موارد، لينتج مؤسسات مترهلة تتنازع على ادارة المدينة لكنها تفعل القليل لتحسن تلك الادارة. يغيب التخطيط وتضيع الاولويات بين الضغوط السكانية التي يمثلها وجود حوالي 7 ملايين قاطن في مدينة تفتقر لمشروع تنموي حقيقي منذ الثمانينيات، وضغوط الصراعين السياسي والمسلح اللذين يواصلان صنع مزيد من الخنادق وتحويل الحدود الطائفية الى حدود مكانية. تظل الكتل الكونكريتية تفصل العديد من المناطق “المتوترة” عن بعضها (وكثير من تلك الكتل يُصّنع من قبل شركات مرتبطة بالأحزاب السياسية المتنفذة!)، وتُوزع “السيطرات” العسكرية (نقاط التفتيش) في أرجاء المدينة دون أن يتغير شيء من واقع أنها المدينة التي شهدت وما زالت تشهد أكبر عدد من السيارات المفخخة في التاريخ. تلك الحواجز تستكمل ما يصنعه العنف، أي ترصين الحدود بين “الجماعات” وجعل قدرة “المواطن البغدادي” على تخيل الانتماء لفضاء مديني موحد ومتنوع اكثر استعصاء.
واذ تقرع “داعش” طبول المعركة القادمة من الأنبار، وتعبئ خلاياها في حزام بغداد “السني”، وتسعى الميليشيات الشيعية الى اعتماد اجراءات وقائية وتحصين خنادقها في مركز المدينة، وتغرق الطبقة السياسية بمفاوضات غير منتجة داخل المنطقة الخضراء التي تمثل الخندق الأكثر تحصيناً، يستعصي تخيل إمكانية تحول قريب في المسار التراجعي للمدينة. يتطلب الأمر ليس فقط نهاية الصراع وتفكيك الخنادق، بل إعادة ترتيب أولويات الفكر السياسي الذي ظل مشغولاً لزمن طويل بالدولة وبالإيديولوجيات الخَلاصية، وأضاع في غضون ذلك المدينة والقرية معاً. وكأنه قدر بغداد أن تكون المدينة التي أثقلت أحمالها كل هذه السلطة التي تجمعت فيها، وأن تكون “المكان” الذي يريد الجميع الاستحواذ عليه، فيدخلون صراعاً متواصلا وطويلاً نتيجته مزيد من التدمير لهذا المكان.
- باحث من العراق