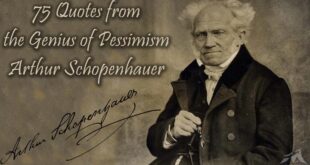شوبنهاور..حــرية الإرادة، العالم إرادة وامتثال
تاريح النشر : الثلاثاء 16-01-2018 04:25 مساء
برهان شاوي
حينما كان (آراتور شوبنهاور 1788- 1860) في الحادية والثلاثين من عمره نشر كتابه (العالم إرادة و إمتثال) الذي لم يلق النجاح في حينه لكنه صار من الكتب الكلاسيكية في الفلسفة الحديثة.
وفي العام 1839 أعلنت الجمعية الملكية للعلوم في النرويج عن مسابقة في موضوع (الحرية)، فتقدم (شوبنهاور) برسالة عنوانها (حرية الإرادة) ففاز بالجائزة.
يقدم شوبنهاور في كتابه (العالم إرادة وامتثال) فلسفة تقوم على قاعدتين هما: إن العالم امتثال، والثانية: إن العالم إرادة.
ولا نريد هنا أن نستعرض فلسفته بكاملها، بل ما يهمنا هنا ما له علاقته بفلسفة الحرية.
لكن هذه الفلسفة عنده لا يمكن تصورها دون رؤية عامة أو الخطوط الهيكلية الأساس لمجمل منظومته الفلسفية، علما أن جميع من بحث وفسر فلسفته يؤكد بأنها واضحة المصادر:
ديكارت، سبينوزا، ايمانويل كانت، أفلاطون، الأوبانيشاد الهندي.
في التصنيف التقليدي المدرسي في الفلسفية تنتمي فلسفة (شوبنهاور) إلى (المثالية الذاتية) من حيث أنه يؤكد بأن كل وجود خارجي يعود إلى الذات، وهذا يعني بأن كل قوانين العالم تنبع من الذات، كما أنه يجعل المادة من صنع العقل، والمادة من ناحية أخرى هي (العلية).
وبالتالي هي الشكل القبلي الوحيد للعقل، وبالتالي يقع في تناقض فاضح في هذه المسألة.
لكنه أيضا يطرح سؤالا ً: هل يسير العالم على نظام؟ ويجيب بنفسه على هذا السؤال بأن العالم يسير على قانون، وهذا القانون هو مبدأ (العلة الكافية). فكل إمتثالاتنا مرتبطة ومرتبة ببعضها بعلاقة سببية، ولا شيء منها يقوم مستقلا بنفسه أو منفصلا ً عن غيره.
ولدى (شوبنهاور) أربعة أنواع من الإمتثالات أو الموضوعات: التأثيرات الحسية، التصورات، الزمان والمكان أو ما تسمى بالعيانات المجردة، ثم المشيئات.
لكن هذه الامتثالات ليست مستقلة الواحد عن الآخر، بل هي أشكال مختلفة لمبدأ واحد هو مبدأ (العلة الكافية).
العالـــم إرادة
(شوبنهاور) يقع في تناقض أوضح حينما يطفر مباشرة إلى (الإرادة) باعتبارها عقلاً يفكر ويمتثل تبعاً لمبدأ (العلية الكافية) أيضاً، وبالتالي فليس الإنسان عقلاً فحسب وإنما هو (فرد) في هذا العالم يمتد بجذوره فيه على هيئة بدن (جسم).
ف(البدن) هو (الإرادة) منظوراً إليه من الباطن، و(الإرادة) هي البدن منظوراً إليه من الخارج. وعلى هذا الأساس فأن كل حركة للبدن هي حركة للإرادة، وكل حركة للإرادة تتجسد في حركة البدن.
وبالتالي فأن (الإرادة) و(البدن) صنوان، أو شيء واحد له مظهران: مظهر مباشر هو الإرادة، ومظهر غير مباشر هو (البدن)، وفعل الإرادة هو عينه فعل البدن، أي أن الإرادة والفعل شيء واحد، لكن النظر العقلي هو الذي يفصل بينهما.
يؤكد (شوبنهاور) بأن (الإرادة) هي جوهر الوجود الإنساني، فهي (الشيء في ذاته)، وهي (الجوهر الخالد غير القابل للفناء عنده، وهي أساس مبدأ الحياة عنده.
بيد أن مفهوم (الإرادة) عند (شوبنهاور) يختلف كثيراً عما هو لدى الفلاسفة الآخرين، فهي ليست تلك (القوة النفسية) التي تأتمر بالعقل وتصدر عندما تتجسد في أفعال عن بواعث يمليها العقل وأحكامه، وإنما هي (غير عاقلة)، (عمياء)، وأن العقل ثانوي بالنسبة إليها.
لكن الرغم من هذا علينا أن نوضح بأن لدى (شوبنهاور) تفريقاً بين الإرادة بالمعنى العام، وبين الإرادة المحدودة بالبواعث والتي تسمى (الاختيار).
فمثل هذه الإرادة عاقلة، أما الإرادة بالمعنى العام فليست عاقلة، لأن (الإرادة المختارة) أو (الاختيار) تؤدي عملها تبعاً لبواعث والبواعث (إمتثالات)، والامتثالات مركزها (المخ)، والحركة التي يقوم بها الإنسان على أساس هذه البواعث هي التي تنتسب لعملية (الاختيار).
أما (الأفعال) التي لا تصدر عن بواعث فتنتسب إلى الإرادة بالمعنى العام لها. لذلك فان (الإرادة) بهذا المعنى تضاف أيضا إلى الكائنات التي لا إمتثالات لها، أي إلى الجمادات.
ويقدم (شوبنهاور) أمثلة على ذلك: فالقوة التي بها ينمو النبات، ويتبلور المعدن، والتي توجه الإبرة الممغنطة صوب القطب الشمالي، والتي بها تتجاذب الأجسام والمعادن، أو تتنافر، أو تتجه إلى مركز الأرض في الجاذبية، هذه القوة هي (الإرادة) وقد تحققت في مظاهر متعددة.
الإرادة ليست هي القوة
(الإرادة) لدى (شوبنهاور) ليست هي القوة، وإنما على العكس أن كل أنواع القوى تدخل تحت مفهوم الإرادة، من حيث أن تصور (القوة) يقوم على المعرفة العيانيه للعالم الموضوعي.
وبالتالي فنحن نستخلص تصورنا عن القوة من علاقة العلة بالمعلول، بينما تصور (الإرادة) لا يقوم على معرفة عيانية وإنما ينبثق من أعماق الشعور المباشر للفرد.
لكن (الفرد) ليس هو (الإرادة)، وإنما هو ظاهرة من ظواهر الإرادة.
فالإرادة هي الشيء في ذاته، وهي بالتالي خارج الزمان والمكان. وهي منفصلة عن ظاهراتها، فلا تعرف الكثرة، فهي إذن واحدة.
ولكنها ليست واحدة كما يكون الفرد واحداً أو التصور واحداً، ولكنها واحدة كشيء يكون مبدأ الفردية، وهو شرط الكثرة، غريبا عنها.
العقــل والإرادة
هناك تناقض واضح لدى (شوبنهاور) في ما يخص علاقة (العقل) و (الإرادة)، فالأول (العقل) هو شرط أساسي لظهور درجات موضوعية الإرادة، و(الإرادة) هي شرط أساسي لظهور (العقل) بوصفه الدرجة الأخيرة من درجات موضوعية الإرادة.
وهذه النظرة تجد جذورها بل وأصولها عند (أفلاطون) و(كانت)، بل إنه قام بنفسه بالإشارة إلى ذلك حيث كتب: (إن المثل الأفلاطونية والشيء في ذاته عند كانت أشبه بطريقين يفضيان إلى غاية واحدة.
فكانت يقول عن الشيء في ذاته: ليس المكان والزمان والعلية من صفات الشيء في ذاته، ولكنها لا تنتسب إلا إلى ظاهرته باعتبارها أشكالا للمعرفة.
ولكن حيثما أن كل كثرة، وكل بداية ونهاية لا تكون إلا بالزمان والمكان والعلية، فينتج عن ذلك أن الكثرة والبداية والنهاية تتعلق بالظاهرة لا بالشيء في ذاته على الإطلاق.
ولما كانت معرفتنا مشروطة بهذه الأشكال، والتجربة بأسرها ليست غير معرفة بالظاهرة لا بالشيء في ذاته فإننا لا نستطيع أن نطبق القوانين تطبيقاً مشروعاً على الشيء في ذاته.
وهذا النقد يشمل ذاتنا نفسها، فنحن لا ندركها إلا في ظاهرتها، لا في حقيقتها أن تنطوي عليها في ذاتها).
(شوبنهاور) يؤكد على أولوية الإرادة على العقل، فهي، الجوهر الحقيقي الباطن للشخصية، وليس العقل أو المعرفة، بينما كان الفلاسفة قبله ينظرون إلى (العقل) على أنه (الجوهر).
شوبنهاور يهتم بمفهوم الفرد اكثر من مفهوم الشخصية
هنا يجب التوضيح بأن (شوبنهاور) يتوقف عند مفهوم (الفرد) أكثر مما يتوقف عند مفهوم (الشخصية)، فكما يوضح (فؤاد كامل) في كتابه (الفرد في فلسفة شوبنهور – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1991) : (لا وجود للأفراد إلا في الدرجات العليا الثلاث من درجات الوجود، وهي العضوية، والحياة، والتفكير.
أما الطبيعة الجامدة فلا وجود فيها لغير (العينات)، غير أن هذه الدرجات الثلاث وإن كان لا يمكن انقسامها في كائن معين، تشارك فيها في الوقت نفسه كائنات متعددة، وأنواع متعددة، وأجناس متعددة أيضاً.
فلا بد لنا من شيء أكثر من هذا نستطيع أن نميز به الأفراد المتماثلين الذين يندرجون تحت نوع واحد، فالعضوية والحياة والتفكير تمثل لنا الشروط العامة للفردية أو الحدود التي لا يمكن أن يقوم خارجها أي وجود فردي).
فالفرق بين (الفرد) و(الشخصية)، فالأول حقيقة بيولوجية طبيعية، بينما الثاني حقيقة روحية، أي الروح كما تتحقق في الطبيعة. (وقد يكون الفرد الموهوب بلا شخصية، بمعنى أنه لا يستطيع أن يبذل من المجهود ما يحقق به شخصيته.
فالإنسان قد يفتقر الى الشخصية ولكنه يظل مع افتقاره هذا فرداً لا نستطيع أن ننزع عنه فرديته) كما يذهب الى ذلك (فؤاد كامل) في كتابه الآنف الذكر.
يمكننا أن نوضح هنا أيضا بأن موقف (شوبنهاور) متطرف في ما يخص تغليب الإرادة على العقل، لكن هذا يقود إلى موقف فلسفي جديد بالكامل، هو (اللامعقولية الوجودية)، فهو يقضي على مسألة سيادة العقل حينما جعل للإرادة السيادة على الحياة النفسية وعلى الوجود بكامله.
وهو بهذا يناقض (هيغل) بالكامل الذي كان يرى بأن (الوجود) هو تطور للفكرة المطلقة أو اللوغوس (العقل)، وربما هنا يمكن الإشارة إلى الغيرة الشديدة والكراهية التي كان يكنها (شوبنهاور) ل(هيغل).
فقد كان الثاني مشهوراً جداً وكان قبلة أنظار المفكرين وطلاب العلم والفلسفة في زمانه، بينما كان (شوبنهاور) يحاضر في الجامعة ولا يحضر القاعة أفراد هم أقل من أصابع اليدين.
عموما لم تعد هذه النظرة تفسر حركة الوجود وفق قواعد عقلية منطقية محكمة.
يشير (فؤاد كامل) في كتابه (الفرد في فلسفة شوبنهور) : (إن الإرادة قد خلقت العقل لكي يحافظ على بقاء إحدى درجات تحققها، وأعني بها الصورة الإنسانية… فالعقل تابع للإرادة خلقته كي تشعر بوجودها، وهو يسارع إلى خدمتها أينما طلبت منه ذلك.
بيد أن العقل – هذا المخلوق الضعيف – يستطيع أن يرمي عن كاهله هذه العبودية وأن يتحرر من ربقتها، لكي يظل نفسه فحسب، مستقلا عن كل غاية إرادية، وكأنه مرآة صافية ينعكس عليها العالم، وهذا هو الفن. كما أنه يستطيع أن يحطم الإرادة تحطيماً كاملاً، ويزهد في كل ما تشير به الإرادة وهذه هي القداسة أو الخلاص من هذا العالم.
وهكذا نرى أن الحياة الأخلاقية بمعناها الصحيح ما هي إلا صراع بين الإرادة والعقل، بين التابع والمتبوع، بين الخادم والسيد).
وحـــــدة الـوجـــــود
إلى جانب أن هذه النظرة تمنح (الإرادة) خاصية أخرى هي (الوحدة)، من حيث أنه يؤكد وحدة الإرادة في الوجود كله، أي (وحدة الوجود)، على طريقة (الفيدا) الهندية، أو (سبينوزا)، لكن بطريقة مختلفة. فكما يؤكد (د. عبد الرحمن بدوي) في (الموسوعة الفلسفية – ج2) : (إن الإرادة عند شوبنهاور وحدة، لكن لا بالمعنى العددي،
ولكن بالمعنى الوجودي، والمعنى العددي هو الذي يقال في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال على سبيل الإطلاق، لا نسبياً، ويدل على البساطة وعدم القابلية للتجزئة والانقسام…. إذن فهو من القائلين بوحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الخالص، لا بالمعنى الديني، أعني بمعنى أن هذا الوجود له مبدأ واحد وحدة مطلقة في ذاته، وإن تعددت المظاهر التي يتحقق عليها موضوعياً.
وهذا المبدأ هو الإرادة، الإرادة العمياء المندفعة. ونراه ينكر وحدة الوجود بالمعنى الديني، أي بمعنى أن العالم هو الله الواحد وما الأشياء الحسية إلا مظاهر متعددة لوحدته المطلقة. ويسوق البراهين التالية: (الأول): أن”الله”غير المشخص ليس بإله، بل هذا تناقض في الحدود غير معقول ولا مفهوم.
ولهذا فأن وحدة الوجود بالمعنى الديني هي في نظر شوبنهور”تعبير مؤدب”ولفظ مهذب لكلمة:”إلحاد”. (الثاني) لأن وحدة الوجود بالمعنى الديني تتنافى مع الكمال الواجب لله، وإلا فما هذا الإله الذي يظهر في صورة هذا العالم الفاسد الرهيب، وفي شخص الملايين التعسة المعذبة وكأنهم زنوج عبيد محكوم عليهم بأشق الأعمال بلا غاية ولا فائدة؟ و(الثالث) لأن الأخلاق لن يكون هناك مبرر لوجودها داخل مذهب يقول بوحدة الوجود.
فلم يكن في وسع شوبنهور، واتجاهه الأخلاقي الأصيل، أن يقول بمثل هذا المذهب. فهو إذن يقول بوحدة الوجود، ولكن بمعنى خاص، هو المعنى الفلسفي الخالص).
إرادة الحيــــاة … حفــظ النـــــوع
الإرادة، كما أكد (شوبنهاور) هي اندفاع أعمى بلا غاية أو هدف. لكنه يتوقف عند الموجودات ليرى تدافعها من أجل البقاء، وكما يؤكد بأننا نرى (كائنات تتوثب في نشوة وحماسة فائضة مؤكدة لذاتها في العيش، وصائحة ملء فيها: الحياة، الحياة..! إنها تعبر إذن عن شعور واحد هو الشعور بالحياة، وتنساق في تيار واحد هو سياق الحياة، ويحدوها ويدفعها دافع هو دافع الحياة.
فهي إذن لا تمثل غير إرادة واحدة، ألا وهي: إرادة الحياة، وإن تعددت المظاهر التي تتخذها والشكول التي تعلن بها عن نفسها، واللغات التي تتحدث بها. وإلا، فعلام كل هذا الجزع ولماذا كل هذا العذاب والألم، والصراع والاندفاع، والعطف والإشفاق، لماذا هذا كله يرتبط بحادث أو ظاهرة في غاية البساطة هي شعور حياة فردية بأنها مهددة بالفناء؟ انه لسبب واحد هو إرادة الحياة).
شوبنهاور يرى أن غاية الطبيعة هو (حفظ النوع)، فما مظاهر الإفراط الشديد في إنتاج البذور، عنف الغريزة الجنسية، ومهارة فائقة في تكييف هذه الغريزة مع جميع الأحوال والظروف والتجائها إلى أغرب الوسائل من أجل مقاصدها، إلا الدليل على أن غاية الطبيعة في كل سيرها ونضالها هو (حفظ النوع).
أما (الفرد) فلا تكاد الطبيعة أن تحفل به في ذاته، وإنما كل قيمته عندها أنه وسيلة من أجل الاحتفاظ بالنوع، حتى إذا ما أصبح غير قادر على تحقيق ذلك، قذفت به إلى الفناء. وهذه هي علة وجود الفرد كما يراها. أما العلة من استمرار النوع والحفاظ عليه فلا يقدم (شوبنهاور) أية إجابة بل إنه يؤكد بأن الطبيعة نفسها لا تقدم لنا أي جواب، ومن العبث أن ننشد الإجابة، لأن حياة الأفراد وموتهم ينفقان بأسرهما في الاحتفاظ بالبقاء، بقاء الفرد في نفسه، وفي ذريته من بعده، أي في الاحتفاظ بالنوع.
كما أنه يتوقف عند حيوان (الخلد) متسائلاً أية غاية ينشد هذا الحيوان الأعمى الذي يعيش تحت الأرض، ولا عمل له طوال حياته غير أن يحفر الأرض بمشقة، وهو الذي يعيش في الظلام، غير الغذاء والجماع، اي حفظ النوع.
إن (شوبنهاور) يتوقف بعناد وشجاعة ليطرح السؤال حول مصدر هذا التعلق الشديد بالحياة؟ ما مصدر هذا الاندفاع للتعلق بهذه الفترة القصيرة التي يقضيها المرء في الوجود والتي يسميها (الحياة)، والتي تبدو لا شيء يذكر وسط تيار الزمان اللانهائي؟.
وفي إجابته على هذه الأسئلة يؤكد (إن هذا التعلق بالحياة هو حركة عمياء غير عاقلة، ولا تفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة للحياة خالصة، وأن الحياة، تبعا لهذا، يجب أن تُعد الخير الأسمى، مهما يكن من مرارتها وقصرها واضطرابها، وغن هذه الإرادة في ذاتها وبطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة.
أما المعرفة، فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة. ولهذا تفعل العكس: تكشف لنا عما لهذه الحياة من ضآلة قيمة. وبهذا تحارب الخوف من الموت).
وفيما يخص (الموت) فأنه، حسب رأيه، لا يصيب (إرادة الحياة)، وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي يجددها باستمرار، من حيث أن (إرادة الحياة) خالدة، والطبيعة ضمنت لها هذا الخلود من خلال (الغريزة الجنسية) التي هي أوضح وأعنف مظاهر (إرادة الحياة)، بل هي (سر السر في الطبيعة).
لذلك فهو نظر إلى (الحب) نظرة جنسية خالصة رابطا إياه بالغريزة الجنسية، (فالحب مهما تسامى وتلطف ينبع من الغريزة الجنسية أو هو الغريزة الجنسية نفسها واضحة ومشخصة. وواهم كل الوهم من يزعم أنه يقوم أو يمكن أن يقوم على الحب الخالص الذي يؤدي إلى السعادة الشخصية لكلا الطرفين).
الإرادة … الخطيئـــة
يؤكد (شوبنهاور) ما أكده (ديكارت) قبله بأن (الإرادة) هي مصدر الخطيئة، لكنه يختلف عنه في التفسير، من حيث (ديكارت) استند على الفكرة المسيحية عن (الخطيئة) بينما (شوبنهاور) يؤكد : (لما انبثقت الإرادة من أعماق اللاشعور كي تستيقظ على الحياة، وجدت نفسها، كفرد في عالم لا نهاية له ولا حدود، وسط حشد هائل من الأفراد المجهدين المتألمين الضالين، ولما كانت منساقة خلال حلم رهيب فأنها تهرع كي تدخل من جديد في لا شعورها الأصيل.
وحتى تصل إلى هذه الغاية، كانت رغباتها غير متناهية ودعاواها لا تنقضي، وكل إشباع لشهوة يولد شهوة جديدة، ولا مرضاة أرضية قادرة على تهدئة جموحها ونوازعها، أو القضاء نهائيا على مقتضياتها أو تملئه هاوية قلبها السحيقة).
إنه يرى الحياة شر، وان الإرادة هي الأصل، فالإنسان يتحمل العذاب والآلام، باذلا كل ما في وسعه للحفاظ على هذه الحياة القصيرة البائسة التافهة، بينما الموت ماثل أمام عينيه في كل فعل وكل شهيق وزفير، متسائلا ألا يؤكد كل هذا بأن السعادة الدنيوية وهم يجب الاعتراف به، وأن جوهر هذا الوجود هو الشقاء والألم؟
وأن هذه السعادة النسبية التي يعيشها البعض ما هي إلا وهم أيضا، لأن كل لذة تتذبذب بين حالتين: حالة الألم قبل أن تدرك، وحالة الملال بعد أن تشبع. وكلتا الحالتين عذاب. ففي الملال يشعر الإنسان بالخلاء، وعدم الاكتراث، والضجر. ومكافحة الملال والضجر أشق من مكافحة الألم، لأنه مجهول الموضوع فلا يعرف الإنسان كيف يصده، ولا يقوى الإنسان على الخلاص منه، وان تخلص منه فما ذلك إلا بإثارة رغبات جديدة توّلد بدورها لألم وحرمان: إذن نحن ندور في عجلة الألم باستمرار.
لذلك فان الفضيلة الأسمى عنده هي إنكار الحياة أو (الزهد) أو (القداسة). وهذا الأمر يتحقق لديه في مظاهر عدة هي : العفة الإرادية، والامتناع عن الخضوع للغريزة الجنسية، الفقر الاختياري المتعمد، قبول الأذى من الآخرين..! ولما لم يكن الزاهد مهتما بشخصه، متنكرا لإرادته فإنه لا يعترض ولا يشكو.
ويعتقد (شوبنهاور) أن أعظم الظواهر وأكثرها أهمية وأبعدها دلالة ليست هي ظاهرة (الفاتح) وإنما ظاهرة (الزاهد) لأن (الزاهد) لا ينتصر على هذا القائد أو ذاك، وإنما ينتصر على (إرادة الحياة) نفسها بكل ما فيها من قوة وعنف.
بيد أن (شوبنهاور) لا يتحدث عن (الزهد) المتعمد فقط وإنما يتحدث عن نوع آخر من (الزهد) الذي ندفع إليه الآلام حينما يصبها القدر أو المصير على نفس من النفوس البشرية، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا:
(فالشعور العميق بالألم يعود في أغلب الأحيان إلى الزهد، وكثيرا ما يكون عند اقتراب الموت، حينما تحطم وطأة الآلام إرادة الحياة وهكذا ينقلب الفرد بين يوم وليلة فيسمو فوق نفسه وفوق آلامه، وكأنما طهرته الآلآم، وباركته وقدسته، ويحيا حياة لا يستطيع الألم أو الشكوى النفاذ إليها أو إزعاجها، ويستقبل الموت دون خوف).
حـــرية الإرادة
بما أن (الإرادة) هي اندفاع أعمى بلا غاية أو هدف، ولا تحكمها الضرورة، إذن فهي حرة. (الفرد) هو معقل الضرورة والحرية في آن واحد، فهو حر تماما لأنه ينتمي من الباطن للإرادة، لكنه أيضا خاضع لضرورة مطلقة تلك التي ترتبط بها دوافعه وأعماله.
وكما تبين لنا إن الإرادة هي التي تتخذ القرارات، إذن فالإنسان حر في إرادته. وقد بين (شوبنهاور) ذلك قائلاً : (يخيل للمرء أن العقل يستطيع الاختيار ولكنه في الواقع لا يختار ولا يستطيع الاختيار، وأما الذي يختار ويرجح دافع على آخر هي الإرادة، والإرادة وحدها، وإنما موقف العقل فإنه موقف الانتظار، بحيث تبدو له القرارات جميعاً ممكنة. وهكذا يتولد لدينا الوهم الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بالحرية التجريبية.
فقرارات الإرادة لا تتكشف للعقل إلا بالتجربة الصرف، وهي لا تصدر إلا عن أعمق أغوار النفس، أي عن الطبع المعقول في صراعه مع الظروف الخارجية، وتكون النتيجة في هذه الحالة ضرورية ويقتصر عمل العقل في هذه اللحظات على إضاءة الدوافع من جميع نواحيها، أما اتخاذ قرار معين فهذا ما يخرج عن نطاق عمله، فلا نفاذ له إلى الإرادة، ولا قدرة له على اختراق أستارها المسدلة دونه).
إن (الحرية) عند (شوبنهاور) تتخذ مفهوماً جديداً، فهي ليست قدرة الفرد على الاختيار، وإنما هي عنده عدم الخضوع لمبدأ العلة الكافية، أي انعدام الضرورة، فهي بهذا المعنى سلبية، لأنها سلب للضرورة، وانتفاء للرابطة بين المبدأ والنتيجة. فهو يؤكد (إن العلل في الحياة الإنسانية، وهي الدوافع، قد تكون نظراً لتعقد هذه الحياة خافية لا ظاهرة، وبذلك نتوهم أن الإنسان حر. ولو أننا قبلنا مبدأ حرية الاختيار لكان معنى ذلك أن يبدو كل فعل إنساني وكأنه معجزة لا يمكن تفسيرها أو تعليلها إذ تكون حينئذ نتيجة بلا علة، وتكون الحياة الإنسانية خاضعة للمصادفة المطلقة وهذه الفكرة تشل الروح تماماً).
عن الحوار المتمدن
الفيلسوف الالماني آرتور شوبنهاور
إن الكلام يطول حين الحديث عن الفلاسفة التشاؤميين لسبب ما ، خصوصا إذا كان الحديث عن أب الفلاسفة التشاؤميين و سيدهم و أكثرهم تشاؤما ، إنه شوبنهور الذي لا يملك الفرد القارئ لفكره و الملاحظ لتصرفاته إلا البقاء عاجزا عن تفسير طبيعة هذا الفيلسوف ، و ليس من العادل محاولة فهم فكر شوبنهور من تصرفاته و آرائه فقط . فهذا من التسرع الذي قد يعود على القارئ بنتائج سيئة أولها الفهم المغلوط للفكر و الطبيعة .
إن كل فيلسوف هو أحجية بشكل أو بآخر فما بالكم فيلسوف كان أحجية للفلاسفة أنفسهم ؛ خصوصا أن هذا المتشائم كان عرضة للتجاهل و الإزدراء لفترة طويلة من حياته ، و حتى هذا اليوم فإنك لن تجد أثرا لمقتطفات من كتبه أو مقالات له إلا في أواخر الكتب المدرسية و إن كانت كثيرة فأكثرها مقالان . عكس نيتشه أو ديكارت أو هيغل الذين تجد بأن المكاتب و المدارس تعج بكتبهم و كتب حولهم ، حتى و لو كانت كتب هيغل صعبة و مملة نوعا ما فإنك تجد لها إنتشارا في المكتاب ، أما شوبنهور الذي تتميز فلسفة بيسر الفهم و الأسلوب فإنه شبه مجهول في بعض الأوساط منها الوسط العربي ،
و بدل أن أستهل الأطروحة بالسؤال المكرر و الممل الذي يعلق في بداية كل أطروحة أو مقال حول أحد الشخصيات التاريخية المجهولة (من هو شوبنهور ) ، سأتفضل و أقول ؛ ما هو شوبنهور ؟ . فماهية شوبنهور أهم من منهويته لأن الكثيرين قد تسرعوا في إعتباره فيلسوفا من ضمن الفلاسفة فألقوْا الضوء على فلسفته و حاولوا شرحها بنفس الطريقة التي حاولوا شرح فلسفة هيغل أو جان جاك روسو أو غيرهم ، و هذا من الخطأ .
فلذالك تجد بعض النقاد يعتبرون بأن شوبنهور مزودج الفكر ؛ فتارة يدعو إلى هذا و هو يقوم بعكس كما في حالة كرهه للمرأة و ممارسته لعلاقات جنسية مع النساء من جانب آخر ، فلا يملك القارئ إلا التسليم بأن هذا المتشائم إنما هو أحد مزدوجي الفكر المختبئين في أثواب الفلاسفة الألمان ، إلا أن الأسباب ستتضح لاحقا مع شرح أكثر لفلسفته .
هو إبن لهينريك فلوريس شوبنهور (1747-1805) و جوهانا شوبنهاور (1766-1838). فأما هينريك فهو تاجر ميسور الحال من دانزج تزوج جوهانا في عنفوان شبابها و كان يكبرها بسنواتٍ سِمان ، إختار تلك الشابة لجمالها و صغرها أما هي فإختارته لثروته و العيش النبيل الذي أحست بتدفقه في منزل ذاك الرجل .
و كان يشاع أن عائلتي الأب و الأم تعانيان من أمراض عقلية و هذا ما أثبته نسبيا إنتحار الأب هينريك بعد أن خسر مبلغا ما في عمله ، كان واضح جدا أن جوهانا الصغيرة لم تحب زوجها أبدا و زوجها بدوره كان يعلم بالأمر ، فكانت عاشقة للحرية و الكتابة و هذا ما لم يرضى به صديقنا آرثر ، كان لآرثر شوبنهور أخت وحيدة إسمها إيديل شوبنهور لم نرى من كتب سيرة آرثر ما يدل على أنها قد تكون ذات أثر على نفسية شوبنهور ،
فهي لم تكن ذات دور مهم في حياة شوبنهور بقدر ما كانت أمه اللهَّاثة وراء الكُتَّاب و الشعراء في زمنها أمثال غوته و غيره . مباشرة بعد إنتحار شوبنهور الأب إنتقلت الأسرة إلي فيمار حيث فتحت هنالك جوهانا صالونا أدبيا أمَّهُ عصبة من الكتاب و الشعراء ، و كانت تحلم بأن تصبح كاتبة روايات و فعلا كتبت رواية بمساعدة أصدقائها ، و الرواية لم تترجم للغة العربية و هي تحت عنوان غبريلا Gabriela (1819), سافر صديقنا آرثر للعيش في فرنس المدة عامين ثم سافر للدراسة في بريطانيا لمدة ستة أشهر حتى كره المدارس البريطانية ،
إلا أنه أتقن اللغة الإنجليزية إتقانا ، و قد إعتاد خلال عيشه في المدرسة الداخلية ببريطانيا قراءة جريدة *ألتيمس * البريطانية ، و سافر إلى عدة دول أروبية مثل النمسا و سويسرا و إطاليا ، قبل أن يعود إلى هامبورغ . بعدها حاول أن يشتغل بالتجارة عمل والده و لكنه سرعان ما فشل في الأمر بعد موت أبيه و كان يبلغ من العمر حينها 17 سنة ،
وعندما إنتقلت أمه إلى فيمار كان لها عالاقات كثيرة مع الكتاب من بينهم غوته الذي سيصبح صديقا لآرثر لاحقا ، إستمرت النزاعات و المناطحات بين آرثر و أمه لتحررها المفرط فيه إلى حدود ، و عندما بلغ شوبنهور سن الحادي و العشرين حصل على مبلغ محترم من إرث أبيه مما يعني تواصلا أقل مع أمه و اعتمادا أكثر على نفسه ،
و في أحد الأمسيات التي نظمتاه جوهانا في منزلها بدوعة أصدقائها جاشت مراجل شوبنهور و ثارت ثائرته فدفعت أمه من أعلى الدرج و قال لها جملته الشهيرة ( لن يذكرك التاريخ بشيء سوى أنك كنت أما لشوبنهور ) ، و هو هذا التاريخ لم يذكرها بشيء سوىء أنها كانت أما لشوبنور و لو لم يبلغ شوبنهور ما بلغ من عمق الفكر و النبوغ ما وجدت جوهانا ضمن مشاهير الروائيات ، فيمكنك ببساطة أن تقوم ببحث عن جوهانا باللغة الإنجلزية في الموسوعة الحرة لتجد هذه العبارة :
was a German author. She is today known primarily for being the mother of Arthur Schopenhauer.
أي أنها تعرف حاليا بأنها أم لآرثر شوبنهور ، إستشاطت جوهانا لهذا الكلام و آرثر لم يبقى مع أمه فترة إضافية ، إذ حمل متاعه و ترك المنزل و لم يرها من ذاك اليوم إلى يوم وفاتها . كان حينها آرثر قد بدأ الدراسة في جامعة جوتنجن سنة 1809 ، حيث تعلم و درس و تمحص في فلسفة كانط كثيرا إلى أن صار مغرما بها . و لم يمضي من الوقت إلا سنتين ليتنقل آرثر إلى برلين عام 1811 لينصب إهتمامه أكثر على دراسة الطب . و قد حضر بعض محاضرات فشته و لم ترقه أبدا ،
و في سنة 1813 حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة برسالته المعنونة ( المبادئ الأربعة للسبب الكافي ) ، و زامن هذا الحدث حرب التحرير الألمانية ( تحرير ألمانيا من جيوش نابليون) ، و قد راودته أفكار لذهاب و المشاركة في تحرير ألمانيا و كان قد إشترى العتاد إلا أنه عدل أخيرا عن الأمر ، من ناحية الشخصية فقد كان شوبنهور حاد الطباع ذكيا جدا و مغرورا واثقا من نفسه كل الثقة ، و كان يظن أنه من غير العادل أن يترك نبوغه مستورا و لا يكشفه للعالم و للناس الذين لم يعرفوا به بعد.
عندما إلتحق بجامعة برلين ( 1919 ـ 1931 ) كان قد بدأ في دراسة الفكر الهندي عامة و البوذي خاصة مما مهد لآرائه الفلسفية المبكرة . تعرف خلال هذه الفترة بالشاعر الألماني الشهير فان غوته الذي كان صديقا لأمه و لا أدري كيف لم يتمكن آرثر من ملاحظة ذالك الأمر ، إذ وطد علاقته كثيرا بغوته إلى أن انفصل عنه غوته بعد أن عرف بكرهه الشديد لمصادقة أمه للرجال ، و كرهه لهيغل و فلسفته.
و من المعروف أن هيغل كان أحد أعمدة الفلسفة الألمانية و ما الطاعن في فلسفته إلا مجنون مسه الجنون . قرر آرثر أن يخصص وقتا لمحاضراته في جامعة برلين هو نفسه الوقت الذي كان يحاضر فيه هيغل في جامعة أخرى
حتى يجر الهيغليين إلى مقاعده و يخلي مقاعد هيغل لأنه في نظره مجرد ثرثار كاذب إستغل فلسفة كانط و طورها بما يناسب مصالحه الشخصية حتى أصبحت فلسفته مجرد سفسطة لا فائدة منها ، إلا أن جذور فلسفة هيغل كانت ضاربة في العقلية الألمانية و لم يكن الألمان ليتوجهوا إلى شوبنهور و يتركوا أستاذهم الجليل.
فخلت مقاعد شوبنهور و إزداد غيظه و كرهه للعالم ، ففسرها على أن الأساتذة يحيكون حائكة للإيقاع به لأنهم كانوا يغارون منه و يحسدونه . إلا أن طريقة شوبنهور في إلقاء المحاضرة كانت تخيف الطلاب و تجعلهم يهجرونه محاضراته هجرا.
كان شوبنهور في هذه المرحلة قد كتب المجلد الأول من كتابه ( العالم إرادة و تمثل ) الذي تعرض لتجاهل عظيم زاد من شؤمه و غضبه ، فلم يقدر أن يتلقف كل ما بادلت النخبة الفكرية به شوبنهور فقرر التوقف عن إلقاء المحاضرات و عيش ما تبقى من حياته في فندق متوسط التكلفة لما تبقى من حياته.
و بعد هذا كتب عدة مقالة في هجو هيجل تحت عنوان ( في فلسفة الجامعات ) ، و ليس هيغل فقط بل عدة فلاسفة آخرين مثل شلنغ و فخته و شمله بوصف المثرثرين و الدجالين إلى جانب هيغل ، مما ساهم في تجاهل الألمان لشوبنهور الذي كان يطعن في ربابنة الفكر و أسياده آنها ، هذا عكف آرثر في غرفته لما تبقى من حياته يصلح و ينقح فكره فنشر كتابه الشهير ( الإرادة في الطبيعة ) 1836.
و يجدر الإشارة إلى أن آرثر كان له كتاب آخر قبل العالم كإرادة و تمثل و هو كتاب في الفن تحت عنوان ( نظرية الأبصار و الألوان ) . و بعد الإرادة في الطبيعة نشر كتاب ( المشكلتان الأساسيتان في الأخلاق ) سنة 1841 ، ثم الطبعة الثانية من كتابه الأول في العالم. كإرادة مع تنقيح و زيادة خمسين فصلا جديدا .ثم كتاب الشهير ( الحواشي و البواقي ) أو كما هو معروف ( النتاج و الفضلات ) سنة 1851 ، و هو كتاب عصر فيه عقله و عجن فيه فلسفته عجنا حتى كاد الكتاب يغني عن باق الكتب في مجلدين إثنين.
بعد ذالك إستمر بنشر مقالات و رسائل صغيرة في مختلف المواضيع مثل المرأة و غيرها . بالنسبة لحياته اليومية فكان ما يقوم به معروفا و متوقعا ، و لم يكن يقدم على الجديد و المثير في حياته ؛ فكان يستقيظ في الصباح و يغتسل ، يحضِّر كوبا من القهوة السوداء و يتجه لمكتبه للعزف على جهاز الفيولا خاصته إلى حدود الظهيرة.
فكان يخرج لتناول الغداء في أحد المطاعم التي كان يتردد عليها دائما ، أما في المساء فكان يذهب إلى قاعة المسرح و يقضي مدة هنالك و بعدها يخرج يتمشى هو و كلبه أطما لمدة طويلة و يتجول في المدينة مهما كان الجو ، ماطرا أو حارا أو باردا لا يهم ، و الحق أنه كان عاشقا للطبيعة كل العشق ، محبا للحياة كل الحب . فكان عادة ما يمارس علاقات جنسية مع العاهرات اللائي يكتريهن لذالك ، فنظر إليه الكثير من النقاد في هذه النقطة على أنه يعاني من إزوادجية فكرية و لا يعمل بما يدعو إليه و أنه مجرد دجال كغيره.
إلا أن هذه الجزيئة وجب أن توضح و تصحح إلى جانب الجزيئة التي تخص تخص تلذذه بالنبيذ الفاخر و الطعام الغالي لمجرد التلذذ و المتعة مع أنه من المعروف أن قد دعا إلى قتل إرادات الحياة من إرادة جنس و أكل و إرادة الحياة نفسها . فالسؤال المطروح هو : هل نحن بصدد إزدواجية فكرية لدى شوبنهور؟
من أول وهلة لا يمكننا إلا التسليم بإزدواجية الفكر لدى شوبنهاور ، إذا علمنا أنه يدعو إلى قتل إرادة الحياة و ما تحويه من إرادات مثل الجنس و الطعام و المتعة … و أنه يكره المرأة كرها شديدا ، فالسؤال إذاً سؤالان هما : لمذا لم يقتل شوبنهور إرادة الحياة و يعمل بفلسفته ؟ و الثاني هو لمذا كان يمارس علاقات مع النساء اللائي طالما إدعى كرهه لهن ؟ . ففي السؤال الأول علينا تبيان موقف شبنهور من نفسه ، الذي أوضحنا سالفا أنه كان معجبا بنفسه مغرورا بذاته واثقا منها ، و كان على ثقة تامة من أنه عبقري يجب أن يبلغ رسالة للعالم.
هذه الرسالة لن تصل للعالم بموته . فلا بأس في حياته ما دام ينذر البشرية و يخبرها بحقيقة يظن بأنها الحقيقة التي وجب أن يكشف النقاب عنها ، أما أولائك الذين لا يقدمون للبشرية سوى الأخذ منها و لا يملكون ـ شرعية ـ حياتهم و لا تواجدهم في هذه الحياة ، فهم لا بأس بموتهم لا بل موتهم أفضل لأنهم لا يقدمون للبشرية رسالة و لا يفيدونها بحياتهم ، حتى أنهم يأخذون و لا يردون يعيشون في عالم الشر و الزيف حالمين متوهمين . أما شوبنهور فلو عمل بفلسفته فأول شيء يجب أن يقوم به هو الإنتحار.
إذ أن هذا ما تدعو إليه فلسفته و إذا انتحر فلن يوصل للبشرية ما يظن بأنه يجب عليه أن يوصله ، هذا ببساطة رأي شوبنهور و سبب إحتفاظه بحياته ، و لا شك أن هذا ليس كل شيء فلم يزل من الأسئلة الشيء الكثير حول تصرفاته ، إذ نقول ما سبب تمتعه بالعاهرات و الفاجرات الألمانيات في زمنه إذا كان يكره النساء فعلا ؟
و الحقيقة أنه يجب نحدد نوع العلاقة التي مارسها شوبنهور مع النساء ؛ فالعلاقة كانت جنسية قحة لم تنزل لمستوى العلاقة الغرامية أبدا ، لذا وجب تبيان موقف شوبنهور من الجنس في هذه الحالة . يرى شوبنهور بأن الجنس هو أداة شريرة بيد المرأة كونها تقوم بالدور الأكبر في عملية التناسل حسب آرثر ، و هذه الأداة هي سبب ولادة و خلق بشر إلى عالم الشر و الشرور و الآلام و بالتالي تعريضهم لهذه الشرور.
فشوبنهور لم يكره الجنس لمجرد الجنس بل كرهه لما ينتج عنه ، أي ولادة بشر إلى عالم الشر و الألم و التضحية بمزيد من الناس و رميهم في فوهة البركان . و هو لم يقل بأن الجنس عملية شريرة في حد ذاتها لمجرد أنها جنس ، بل و كما ذكرنا لأنها عملية تسبب في إرسال أطفال جدد إلى عالم الشر الذي كان يود من البشر أن يغادروه فغدوْا يُعَمِّرون فيه بالتناسل و التكاثر .إذاً فشوبنهور لم يقل أبدا أن الجنس الغير مسؤول عن خلق الأطفال هو عملية شريرة.
نعم كونها غريزة تدفعنا للبقاء و لكنها أولا ليس بالنسبة لشوبنهور الذي أوضحنا سابقا أنه يرى في بقائه منفعة للبشرية ، ثانيا أنه سبق و وصف المرأة ب ( النبات الحيواني للرجل ) ؛ أي أنها مجرد أكل يتغذى به الرجل و يطعم به جسمه ليستمر في الحياة ، تماما مثل باقي الحاجات البيولوجية مثل الأكل و الشرب و التبرز ، فممارسة الجنس هي حاجة بيولوجية لا تختلف عن الأكل و الشرب و قضاء الحاجات . فنجد أن شوبنهور يحدد أكثر أنه ليس منتظرا منه هو تطبيق فلسفته و قتل إرادة الحياة إذ يقول (المتصوفون وحدهم يستطيعون السمو عن إرادات الحياة ) ، و هنا يخص بكلمة المتصوفون البراهمة البوذيين الذين أعجب بهم أشد إعجاب , فهو لم يدعي يوما أنه على مقدرة أو أنه هو الذي سيطبق فلسفته حسن تطبيق .إستمر شوبنهور على هذا المنوال لمدة أربعين سنة قضاها في الفندق ، طباعٌ حادة ، لباقةٌ في الكلام ، تشاؤم و حزن .
عاش هكذا كل حياته بين تقلبات فكرية و مصائب حلت به هو و بدولته . إلى أن جلس في أحد الصباحات إلى مائدة فطوره مدة مطولة إستغربت خادمة الفندق تلك الجلسة المطولة ، فإقتربت تفحصه لتكتشف أن الحياة قد فارقته فِراقاً . مات و هو جالس على كرسيه . رحل و بدأت مؤلفاته تنتشر في ألمانيا و أروبا ليحضى بالشهرة التي طالما تاق إليها . و لكن بعد موته و لا فرق . حفر إسمه بين كبريات الأسماء و عظيمات أسماء الفلاسفة العظام ليظل رمزا للشؤم و المشأمة ، للحزن و التوحد و العزلة . هكذا فارق الحياة فترك فيها أطنان أفكار و بضع كتب و رزما من المقالات التي حرق بعض و نشر الآخر .
” شوبنهاور مربّياً”: نيتشه في سفره الأول
شوقي بن حسن
أن نقرأ كتاب فريدريك نيتشه “شوبنهاور مربّياً”، فذلك يمثّل فرصة لتخليص صاحب “العالم إرادةً وتمثلاً” من صورته الملازمة له كفيلسوف للتشاؤم. في الكتاب، الذي نقله إلى العربية الكاتب العراقي قحطان جاسم، نكتشف تلك الحبال السرية التي تربط بين فيلسوفين مؤثّرين في تاريخ الفكر. صدر العمل مؤخّراً عن كل من “منشوات ضفاف” و”دار أوما” و”دار الأمان” و”منشورات الاختلاف”.
يُصنَّف “شوبنهاور مربّياً” (1874) ضمن الموجة الثانية من مؤلّفات نيتشه التي بدأت بعمله “مولد التراجيديا” (1872)، وهي تأتي ضمن سلسلة بعنوان “تأمّلات في غير أوانها”، التي يغلب عليها الطابع السجالي.
يبدأ الكتاب بهذه الحكاية: “ذلك المسافر الذي رأى العديد من البلدان والشعوب كان يُسأل: ما هي الطبيعة البشرية التي وجدها لدى كل الناس، فيجيب: النزعة إلى الكسل”. يرى نيتشه أن البشرية طوّرت أخلاقاً من عدم الثقة والخوف؛ فالإنسان على يقين داخلي بأنه بلا مثيل في هذا العالم، لكنه واقعياً يخفي ذلك.
”
ينتصر الكتاب لفكر حقيقي وقاس ضد سوء استعمال الفلسفة
”
هنا يتساءل نيتشه لماذا؟ ثم يجيب “إنه الخوف من الجار، وفي منطقة الخوف هذه يُقوقع نفسه”. لكن ما الذي يجبر الإنسان على الخوف من الجار، وهو الأمر الذي يوقعه في اتباع القطيع؟ إنه البحث عن الراحة، أي ذلك الكسل الذي تحدّث عنه “المسافر”.
يقول نيتشه في هذا النص الأول من الكتاب “لا يوجد في الطبيعة مخلوق كئيب ومثير للاشمئزاز أكثر من الإنسان، لأنه هارب من عبقريته”. إنها إشارة لطيفة قبل أن يختم النص بالتفاتة إلى المعلّم: “حين نريد العودة إلى الذات، ليس أفضل من العودة إلى المربّي، لذلك أريد أن أتذكّر اليوم شوبنهاور”.
الفصول السبعة اللاحقة عبارة عن إعادة تركيب للعلاقة بين نيتشه وفيلسوفه المفضّل، إذ يعتبر نفسه من القرّاء الذين عرفوا من أول صفحة قرؤوها لشوبنهاور أنهم سيقرؤونه كاملاً.
أكثر من ذلك، يشير المؤلف بصراحة أقرب إلى البراءة الطفولية أنه اعتقد أن شوبنهاور كتب من أجله، ويفسّر ذلك بأن هذا الأخير كان يكتب ببساطة لنفسه، ولم يكن يهمّه بريق الحياة الاجتماعية، فلا هو يحب أن يغالط غيره ولا يحب أن يغالط نفسه.
هكذا أحب نيتشه في شوبنهاور “قول ما هو عميق ومؤثّر دون بلاغة”، وهو منهج سيكون صاحب “هكذا تحدّث زاردشت” أحد أبرز مجسّديه لاحقاً. لكن الأهم من هذه العلاقة الشخصية بين كاتب وقارئ، هو أن العمل يكشف ميكانيزمات تسرّب الأفكار بين الأجيال الألمانية في ذروة النشاط الفكري في بلاد بسمارك وزمنه.
من هذه الزاوية، يتيح لنا العمل أن نرى القنوات التي تمرّ من خلالها الثقافة بين الأجيال، عبر التأثّر بما هو أبعد من قراءة نص، حيث يتجاوز ذلك إلى تبنّي روح. إنه عمل يتحدّث في عمقه عن أشكال أخرى لتناقل المعرفة الفلسفية، في وقت رأى فيه صاحب “المعرفة المرحة” أن الفلسفة التي تنتجها الجامعة سقطت في السمعة المشوّهة.
نكاد هنا نستشفّ أن الكتاب يحب أن ينتصر لفكر حقيقي وقاس على حساب ما يراه من سوء استعمال للفلسفة، سواء من قبل الدولة التي تريد منها أن تكون وسيلة ناجعة في صياغة “المواطن الطيّب المطيع”، أو من قبل الفلاسفة أنفسهم الذين جعلوا منها مجرّد أوسمة.
لم يعتمد المؤلّف الكتابة الشذرية كمعظم أعماله اللاحقة، إذ يبدو أنه لم يكتشف مزاياها بعد. لكنه، في المقابل، يظهر في محطات كثيرة من العمل وكأنه على بعد خطوة مما سيُنتجه لاحقاً من أفكار ومفاهيم. فهو مثلاً حين يجد في شوبنهاور أنموذجاً لمن وصل إلى “أصالته المنتجة” التي هي نواة كل كائن، نشعر أن الجملة نفسها يمكن صياغتها بمصطلحات نيتشه اللاحقة كـ “الإنسان الأسمى” و”إرادة القوة”.
أخيراً، يشير “شوبنهاور مربّياً” إلى شجاعة يكاد يفتقدها المفكّرون؛ حيث يكشف نيتشه عن مصادره الفكرية، ويتركنا نلمس أريحيته في عرض افتتانه بمعلّمه، ولعلها سمة نادرة: عدم الخجل من التتلمذ.